شموع ودموعهذه قصة أشخاصها خيال، أتحدّث باسم بطلها حتى أستطيع تقمّص شخصية البطلمقدّمة
والغوص فيها بكل أحاسيسي..
القصة اجتماعية نفسية، إختلط فيها الواقع بالخيال. كتبتها كما تكتب القصيدة، وبكل
أعراض كتابة الشعر من معاناة ومخاض..
كنت أعيشها حقيقة بكل مشاعري. سكبت فيها فرحي كلّه في مواقف الفرح، وعطنتها دمعا وحزنا في ساعات الحزن..
أرجعت كبسولة زماني وعشت الشباب بكلّ حيويته روحا وجسدا..
استغرق تأليفها شهرا بالتمام والكمال، عشته عريسا كامل الدسم. حتى وصفني من حولي بالمراهق العجوز.
هذه القصة وقصص أخرى أرجو أن ترى النور ليست وليدة اللحظة، لكنها ظلّت بدواخلي في حالة بيات لعشرات السنين، وقدّر الله أن تخرج من مكمنها وكنت أظنّها ذابت مع السنين. لكنني الآن رغم تجاوز سن الانفعال أشعر أنني أستطيع تحمل المخاض لإخراج ما ظلّ كامـنا في دواخـلي بعد طول سـنين..
شموع و دموعامتحنت الشهادة الثانوية المساق الأدبي في أوائل العقد الثامن من القرن العشرين، وتحصّلت على نسبة لا غبار عليها أدخلتني كلية التجارة بجامعة القاهرة بالخرطوم. ولمّا كانت المحاضرات تبدأ بعد الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءاً، كان لابدّ من إيجاد عمل لمقابلة المصروفات الكثيرة. وكان المأكل المشرب والسكن وكل الحاجات زهيدة ولاتتعدى في جملتها نصف راتب خريج الثانوي (Scale J) لو نظّم نفسه وابتعد عن الموبقات. أو كان متزنا في موبقاته. ولمّا كانت الموبقات أمرا عاديا ومن لا يتعاطاها غير عادي بمفهوم جاهلية ذلك الزمان الغابر، حيث كان الخمر مباح و على قارعة الطريق، وللفاحشة تسجيلات وتراخيص وصفوف تتفوّق على صفوف التموين في زمن إنعدمت فيه صفوف التموين، كان الاتزان في ذاك الزمان هو الحل الأمثل. ولم تتعدى موبقاتي وأصدقائي سهرات الخميس فوق أسطح الفنادق. كنا أربعة أصدقاء من الطلاب الموظفين. أنا و سليمان و نبيل (بلبل) و ذلك الأعرابي الطاهر الذي كان يفارقنا عند باب الفندق حيث لم تفلح محاولات بلبل لجره لعالم الضوضاء والهجيج. كان الثلاثة يعملون في أحد البنوك بينما أعمل أنا في وزارة سيادية (مجرّد كاتب) ولكن راتبي لم يكن يقل عنهم، بل يزيد، خاصة و أنني كنت أعمل بمكتب الوزير وأتقاضى حوافز و بدل وجبة ثلاثة جنيهات كل خميس، كانت تكفي لمقابلة الضرورات و الرفاهات المتّزنة. وكان أصدقائي هم:ـ1
سليمان:ـ أحبّهم إلي قلبي كان وسيما رقيقا ومتزنا ومهتما بالدراسة والجامعة، وكان يعينني كثيرا فيما يفوتني من محاضرات بسبب العمل الإضافي في مكتب الوزير أحيانا. بل كان في أيام الامتحان يترك أهله ويرحل معي في منزل العزّاب..
نبيل:ـ (بلبل)كان يعاني كثيرا من لا مبالاته. كان يوم الخميس عندما نقترب من الفندق إياه، يردد أغنية خليل إسماعيل (بكره ياااا قلبي الحزين تلقى السعااااادة) كان صوته شجّيا، هو بلبل بالفعل (إسم على مسمّاه) كنّا بعد سماع النغمة الإبليسية الشجية، لا نمتلك إرادة، فنصعد السلّم الوحيد الذي يسهل صعوده ويصعب نزوله. هكذا كنت أصف سلم الفندق المؤدي لحديقة السطوح فوق الطابق الرابع..
الطاهر:ـ ذاك الأعرابي الهميم، كان عاقلا لدرجة الهبل (وهكذا كان العقل يسمى هبلا) هذا الأعرابي جمع المال و تزوّج من بنت خالته ونحن في السنة الثالثة، وحتى في احتفالنا به ليلة عرسه لم يشاركنا الثمالة. و لكن رغم اختلافه عنّا، لم نكن نفترق أبدا إلا عند باب السلّم. أقصد باب الفندق. كنّا أربعتنا نلتقي عند الثالثة في مطعم الإخلاص بالسوق العربي (وما أشهاه من مطعم) كانت طبخاته الفاصوليا والرجلة والسبانخ أفضل من طبخ الكثير من ستات البيوت القديرات. والمكرونة بالفرن، وما أدراك ما المكرونة بالفرن، صاحت عصافير بطني. والتحلية الكريم كرملة، سال لعابي. ونذهب بعد الغداء إلي جامعة وصفها أحد وزراء ذلك الزمان بجامعة مابعد الغداء!! وما أكثرك اليوم يا جامعات على مدار الساعة!!!
كانت السنة الأولى في كلية التجارة صعبة جدا، إذ كان عدد المقبولين ثلاثة آلاف طالبا في مدرّج واحد يسمونه الصين الشعبية. وكان بعض الطلاب بحضرون وقوفا وعبر النوافذ و الأبواب. وبالرغم من لكننّا كنّا نحتل موقعا أماميا مخصصا لنا، إذ كان بعض الأصدقاء من الجنسين المتفرغين للدراسة يأتون مبكّرين ويحجزون لنا المحل بشنطهم. وقد كنّا في البداية نواجه الكثير من الاحتجاجات، ولكن بمرور الأيّام أصبح الموقع حكرا علينا ولا يستطيع أحد احتلاله حتى ولو لم يكن محجوزا بالشنط الستاتية. وعلم المحاسبة لمن لا يعرفه يكون في البداية صعبا، ومعظم الطلاب يخرجون من المحاضرة كمن سمع لغة لايعرفها (رطانة). أما نحن الأربعة فقد كنّا بحكم عملنا في نفس المجال نفهم جيدا، ونشرح للزملاء بعد المحاضرة ونعطيهم دفاترنا ليستعينوا بها. و ربما كان هذا سر حرصهم الشديد على حجز الأمكنة. وقد كنّا محظوظين جدا، إذ كان يزور الجامعة في ذلك الزمان عدد كبير من الأساتذة المصريين الذين يعتبرون من دهاقنة علم المحاسبة في العالم كله، أمثال الدكتور بلبع (إمبراطور علم التكاليف) والدكتور توفيق الذي شغل منصب رئيس الوزراء في مصر وكان متخصصا في المحاسبة المالية. والدكتور حلمي المنمّر، وآخرون كثر، رحمهم الله أحياءاً كانوا أو أمواتاً، بقدر ما أفادونا وجعل عملهم الجليل في موازين حسناتهم..
وكان من أبرز معالم الجامعة العم سعد، وهو عامل في الجامعة لأكثر من أربعين عاما. كان ينهي ويأمر ويحترمه الكبار قبل الصغار. الكل يكنّ له كلّ الاحترام والتقدير. طلبة ومعيدين وحتى الأساتذة الكبار. قال لنا عنه الدكتور حلمي:ـ (عمّكم سعد هذا لوكان يسمع كلمة واحدة كل مرة يدخل فيها المدرّجات، لصار مدير الجامعة).
ومن معالم ساحة الجامعة المشهورة ذاك السبّاح الأسمر طويل الاطراف والقامة. دخلنا الجامعة ووجدناه (إن لم تخني الذاكرة) في السنة الثانية في كلية الحقوق كان يقف في ساحة الجامعة شامخا مثل تمثال رمسيس الثاني، ويتحلّق حوله الشباب من الجنسين، ولا أدري ماكان يقوله لهم ويستمتعون ويضحكون. وماكان عندنا طاقة للوقوف بعد المحاضرات بعد إرهاق اليوم الطويل. تخرجنا في الجامعة وتركنا صاحبنا يمارس هواية الوقوف في ساحتها، ولا أدري متى تخرج. لكنه بالتأكيد كان يأتي للجامعة ترويحا عن نفسه وماكان يحتاج شهادة أو وظيفة.
و المعلم الثالث هو تلك الكلاب الكسولة التي تحتل مكانا ثابتا في الساحة الكبيرة، تقتات من فضلات ساندوتشات الطالبات، حين كانت هنالك فضلات، وحين كنّ يأكلن كما تأكل العصافير..
وجاء يوم الامتحان (يوم يُكرم المرء أو يهان) ونهاية السنة الأولى ونجحنا أربعتنا في كل المواد، وكذلك أصدقاؤنا من الجنسين وكل المتعاونين معنا في حجز الأمكنة، المستفيدين من خبراتنا و دفاترنا، لم يتخلّف منا أحد رغم أنّ المنتقلين للسنة الثانية كانوا ستمئة فقط من مجموع الثلاثة آلاف نسمة. وبقي أربعة أخماس المدرّج مكانهم في مدرّج الصين الشعبية. وكانت فرحتنا بالنجاح كبيرة. واستمرّ حالنا على نفس المنوال طيلة السنوات الأربع حتى تخرجنا أربعتنا دون تخلف ولم نترك سهراتنا الخميسية الممتعة. وحتى في الإجازات كنّا نلتق عند مدخل فندق الليدو الشهير في تمام السابعة مساء كل خميس، وحتى بعد التخرج لفترة، كنا نمارس اللقاءات حتى فرّق بيننا الزمان.
إغترب سليمان و بلبل لبنك أبوظبي الوطني و بقي إبراهيم في بنكه وبقيت أنا في وزارتي مفتّشا بالدرجة (Q) بدلا عن مجرّد كاتب. وفي ذات بوم عمل شاق خرجت من الوزارة متوجها نحو محطة البصات دون أن أتوجه لمطعم الإخلاص كعادتي منذ سنين لتناول وجبة الغداء. كنت مرهقا جدا فقررت أن أذهب للبيت (بيت العُزّاب) مباشرة وأنوم، ثمّ بعد ذلك أفكّر في طريقة أتغدى بها، حتى لو اضطررت أن أتغدى بالزبادي والطحينية. وتوجهت لمحطة البصات، و ركبت بعد عراك عنيف واحداً من تلك البصات البالية ذات اللون الأزرق الباهت. تحرك بنا البص متلكئا عبر الشوارع المزدحمة حتى نمت من فرط تعبي نوما عميقا. وصحوت إثر وقوف البص في المحطة الواقعة جنوب حديقة القرشي. يالله كان حلمي طويلا أثناء النوم. خطبت وسافرت للبلد وتزوجت في حفل بهيج شاركني فيه أصدقائي الثلاثة. حلم طويل جدا، يستغرق أياما عدة لو حدث في الواقع، ويستغرق ساعتين من الحكي المتواصل لو قصصته لكم. وكل ذلك لم يستغرق سوى عشرة دقائق تقريبا. وبدأت أفكّر بطريقة فلسفية في مقاييس الزمان بين الحلم واليقطة.
|



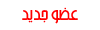

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس