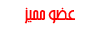النثر الحديث:
«في النصف الأول من القرن التاسع عشر، کان النثر في هذه الفترة رکيك الأسلوب يعتمد علی المحسنات البديعية، مسيطرا عليه طريقة القاضي الفاضل علی أساليب کتاب عصره و نهج نهجه، فبدت علی أساليب هؤلاء مظاهر التکلف فأسرفوا في المحاکاة وأوغلوا في الصنعة، وتعمد تصيد الألفاظ والأساليب ذات البريق واللمعان». [23]
في بدايات النثر الأدبي الحديث «کانت القرائح حبيسة الأغراض الضيقة والمعاني التافهة، وقلّما کانت تتجاوز الرسائل الاخوانية، من تهنئة بمولود، أو تعزية بفقيد، أو معاتبة لصديق، وقلّما تعدی موضوع النثر هذه الحدود الضيقة ليلامس اهتمام الناس ويعالج شؤون المجتمع». [24] «انطلق الفکر الحديث ناشطا و راح يرود آفاقا أرحب تتصل بالواقع وبالمجتمع، نتيجة انتشار أنوار النهضة في أرجاء المشرق العربي. وبدأت الأساليب تتحرر في بعض جوانبها من قيود التصنع اللفظي. غير أن فئة من الناثرين ظلت علی تعلقها بالعبارات المنمقة، وراحت تجد فيها نمطا أدبيا متميزا لا يحسن التفريط به. ومن هذا المنطلق ساغ للشيخ ناصيف اليازجي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فن المقامات؛ فدأب علی إحيائه، وجهد في النسج علی منواله… وفي الوقت نفسه کان ثمة ناثرون رواد ومؤلفون کبار أخذوا يراوحون بين النثر المقيد والنثر المرسل، ترفدهم في الحالين موهبة فذة، وفي مقدمة هؤلاء أحمد فارس الشدياق، أحد أرکان النهضة الفکرية، ورائد الصحافة الأدبية». [25]
ويمکن القول بأن اتصال الشرق العربي بالغرب ظل قاصرا في أول الأمر علی النواحي العلمية والفنية التطبيقية. أما النواحي الأدبية فظل فيها الاتصال معدوما. وطبيعي ألا تنهض اللغة وتظل علی عهودها السابقة جامدة راکدة مثقلة بالسجع والمحسنات البديعية». [26] واشتد احتکاك الشرق العربي بالغرب في منتصف القرن التاسع عشر و «أرسلت طائفة من الشباب المصري إلی أوربا وعلی رأسها رفاعة الطهطاوي «الذي تعلم في الأزهر وتخرج فيه، و رافق البعثة الکبری الأولی لمحمد علي إماما لها. ولم يکتف بعمله، بل أقبل علی تعلم اللغة الفرنسية، حتی أتقنها. وفي أثناء إقامته بباريس أخذ يصف الحياة الفرنسية من جميع نواحيها المادية والاجتماعية والسياسية في کتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز». وعاد إلی مصر فاشتغل بالترجمة وعيِّن مديرا لمدرسة الألسن، وأخذ يترجم مع تلاميذه آثارا مختلفة من اللغة الفرنسية. وکان ذلك بدء النهضة الأدبية المصرية، ولکنه کان بدعا مضطربا، فإن رفاعة وتلاميذه لم يتحرروا من السجع والبديع، بل ظلوا يکتبون بهما المعاني الأدبية الأوربية. ومن الغريب أنهم کانوا يقرءونها في لغة سهلة يسيرة، ثم ينقلونها إلی هذه اللغة الصعبة العسيرة المملوءة بضروب التکلف الشديد، فتصبح شيئا مبهما لايکاد يفهم إلا بمشقة». [27]
«هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل تتعلق بالأدب في تلك الحقبة، وهي الالتفات من بعض الکتاب إلی موضوع الوطن والوطنية، بالمفهوم الحديث تقريبا؛ فقد کان الوطن من قبل ذائبا في جملة العالم الإسلامي أو دولة الخلافة، وليس له دلالة خاصة، وبالتالي ليس هناك کتابات تدور حوله وتتغنی به. أما الآن ومع کتابات رفاعة الطهطاوي بصفة خاصة، فنحن نجد فکرة الوطن تبرز، والتغني به يبدأ، حتی ليمکن أن يعتبر ما کان من ذلك حجر الأساس في الأدب المصري القومي في العصر الحديث. وهکذا نری أن رفاعة الطهطاوي يعتبر واضع بذور التجديد في الأدب المصري الحديث، فأدبه يمثل دور الانتقال من النماذج المتحجرة التي تحمل غالباً عفن العصر الترکي إلی النماذج المجددة التي تحمل نسمات العصر الحديث». [28] «وکان لازدهار النثر الفني عوامل کثيرة من بينها: العناية بدراسة اللغة العربية وآدابها في الأزهر والمدارس والمعاهد والجامعات، وإحياء مصادر الأدب العربي القديم وطبع أحسن مؤلفات الأدباء المعاصرين، وظهور المجلات الأدبية، وعناية الصحف اليومية بالأدب، وإنشاء دارالکتب المصرية، وکثرة ما ترجم من آداب الغرب إلی العربية، وتعدد الثورات الشعبية، التي احتاجت للخطابة، وقيام الصحف مما دعا إلی نهضة الکتابة». [29]
تطور النثر بعد الحرب العالمية الأولی، وظهر الاتجاه الأدبي الذي يدعو أصحابه إلی الأسلوب الفصيح الرصين الجزل، حتی يکون لأدبهم موقع حسن في الأسماع والقلوب، فهم يحرصون علی الإعراب وعلی الألفاظ الصحيحة. وکانوا في إطار تجديد، لا يخرجون عن أصول العربية، ويقوم هذا الاتجاه علی التحول والتطور في اللغة العربية علی نحوما تحولت وتطورت الآداب الأوربية، دون قطع صلتها بالقديم، ومن أصحابه في مصر، طه حسين، هيکل والعقاد. وهذه النزعة المجددة کانت إحياء للقديم وبعثا وتنمية في صور جديدة، ويعتمد علی عنصرين متکافئين وهما المحافظة علی إحياء القديم والإفادة من الآداب الغربية. [30] وقد ظهرت، في أواخر القرن التاسع عشر، أربع طوائف في النثر وهي: طائفة الأزهريين المحافظين، وطائفة المجددين المعتدلين الذين يريدون أن يعبرو بالعربية دون استخدام سجع وبديع، وطائفة المفرطين في التجديد الذين يدعون إلی استخدام اللغة العامية، ثم طائفة الشاميين، التي کانت في صف الطائفة الثانية، واشتدت المعارك بين الطائفة الأولی والطوائف الأخری، حتی انتصرت طائفة المجددين المعتدلين، فعدل الکتاب إلی التعبير بعبارة عربية صحيحة لا تعتمد علی زينة من سجع وبديع، بل يعتمد علی المعاني ودقتها. [31]
وکان محمد عبده علی رأس طائفة المجددين المعتدلين. وهو الذي أخرج الکتابة الصحفية من دائرة السجع والبديع إلی دائرة الأسلوب الحر السليم. وکوّن لنفسه أسلوبا قويا جزلا، ومرّنه علی تحمل المعاني السياسية والاجتماعية الجديدة والأفکار العالية، ومعنی ذلك أنه طور النثر العربي من حيث الشکل والموضوع. [32]
ثم جاء تلميذه لطفي المنفلوطي فقطع بهذا النثر شوطا کبيرا بکتبه ومقالاته، فأنشأ أسلوبا نقيا خالصا ليس فيه شيء من العامية ولا من أساليب السجع الملتوية إلا ما يأتي عفواً، ولم يقلد في ذلك کاتبا قديما مثل ابن المقفع والجاحظ بل حاول أن يکون له أسلوبه الخاص، فأصبح النثر متحررا من کل أشکال قيود السجع والبديع، وبذا يعد المنفطوطي رائد النثر الحديث. وکانت الشهرة التي حظي بها المنفلوطي، تعزی إلی أسلوبه أکثر مما تعزی إلی مضمون مقالاته. وهو أدرك الحاجة إلی تغيير أساليب اللغة العربية، وکثيرا ما عبّر عن اعتقاده بأنّ سرّ الأسلوب کامن في تصوير الکاتب تصويرا صادقا لما يدور في عقله من أفکار. [33]





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس