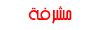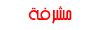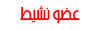تفسيرسورة النجم
قال البخاري: حدثنا نصر بن علي, أخبرني أبو أحمد ـ يعني الزبيدي ـ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق, عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة «والنجم» قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه, إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه, فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمية بن خلف, وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به, وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل, فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة.
بِسْمِ اللّهِ الرّحْمـَنِ الرّحِيمِ
** وَالنّجْمِ إِذَا هَوَىَ * مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىَ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىَ * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَىَ
قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه, والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق, رواه ابن أبي حاتم: واختلف المفسرون في معنى قوله: {والنجم إذا هوى} فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني بالنجم الثريا إذا سقط مع الفجر, وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير, وزعم السدي أنها الزهرة, وقال الضحاك {والنجم إذا هوى} إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه. وروى الأعمش عن مجاهدفي قوله تعالى: {والنجم إذا هوى} يعني القرآن إذا نزل, وهذه الاَية كقوله تعالى: {فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين} وقوله تعالى: {ما ضل صاحبكم وما غوى} هذا هو المقسم عليه, وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال, وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم, والغاوي هو العالم بالحق, العادل عنه قصداً إلى غيره, فنزه الله رسوله وشرعه, عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتمانه, والعمل بخلافه, بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد, ولهذا قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى} أي ما يقول قولاً عن هوى وغرض {إن هو إلا وحي يوحى} أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد, حدثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليدخلنّ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ـ أو مثل أحد الحيين ـ ربيعة ومضر» فقال رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر ؟ قال: «إنما أقول ما أقول».
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس, أخبرنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه, فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق» ورواه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة, كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور, حدثنا عبد الله بن صالح, حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس, حدثنا ليث عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا أقول إلا حقاً قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله ؟ قال: «إني لا أقول إلا حقاً».
** عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىَ * ذُو مِرّةٍ فَاسْتَوَىَ * وَهُوَ بِالاُفُقِ الأعْلَىَ * ثُمّ دَنَا فَتَدَلّىَ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىَ * فَأَوْحَىَ إِلَىَ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىَ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىَ * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىَ مَا يَرَىَ * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىَ * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىَ * عِندَهَا جَنّةُ الْمَأْوَىَ * إِذْ يَغْشَىَ السّدْرَةَ مَا يَغْشَىَ * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىَ * لَقَدْ رَأَىَ مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الْكُبْرَىَ
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس {شديد القوى} وهو جبريل عليه الصلاة والسلام, كما قال تعالى:{إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين} وقال ههنا {ذو مرة} أي ذو قوة, قاله مجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن, وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» وقوله تعالى: {فاستوى} يعني جبريل عليه السلام, قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس {وهو بالأفق الأعلى} يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى, قاله عكرمة وغير واحد. قال عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. وقال مجاهد هو مطلع الشمس. وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار, وكذا قال ابن زيد وغيرهم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة, حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسم, حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف, حدثني أبي عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة, أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين: أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق. وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد فذلك قوله: {وهو بالأفق الأعلى} وقد قال ابن جرير ههنا قولاً لم أره لغيره, ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى, أي استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراء, كذا قال ولم يوافقه أحد على ذلك, ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال وهو كقوله: {أئذا كنا تراباً وآباؤنا} فعطف بالاَباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله فاستوى وهو, قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده:
ألم تر أن النبع يصلب عودهولا يستوي والخروع المتقصف
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه, ولكن لا يساعده المعنى على ذلك, فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها, ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض, فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها, له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء, وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة, فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ, ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء, يا محمد أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل, فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه, وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليها, له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق, فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به, فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه.
فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب, حدثنا سعيد بن منصور, حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي, فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الاَخر. فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين, وأنا أقلب طرفي, ولو شئت أن أمس السماء لمسست, فالتفت إلي جبريل كأنه جلس لاطىء فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم, وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي» ثم قال البزار: «لا يرويه إلا الحارث بن عبيد, وكان رجلاً مشهوراً من أهل البصرة.
(قلت) الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الأيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعفه, وقال: ليس هو بشيء, وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حيان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد, فهذا الحديث من غرائب رواياته, فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباً ولعله منام, والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج, حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح, كل جناح منها قد سد الأفق, يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك, فدعا ربه عز وجل فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر, فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه, تفرد به أحمد.
وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام فتجهزت معهما, فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولاَذينه في ربه سبحانه وتعالى, فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له, فذكر له ما قاله, فقال: فما قال لك ؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال: يا بني والله ما آمن عليك دعاءه, فسرنا حتى نزلنا الشراة وهي مأسدة ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال لنا أبو لهب: إنكم قدعرفتم كبر سني وحقي, وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة, والله ما آمنها عليه, فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها, ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع, فشم وجهه ثم هزمه هزمةً ففسخ رأسه فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد.
يتبع ..