بعد أن طرح الموضوع الذي كلفت به
نأتي إلى حل سؤال المتابعين
يقول السؤال:
من المعروف أن الأجداد كانوا يهتمون بتربية الكباشة لغرض البيع والإنتفاع بثمنها أو للأكل والتلذذ بلحومها.
وقد كان الأجداد يفضلون الكبش المخصي ويغالون في ثمنه يليه الكبش الموجى وكلنانعرف الوجاية والخصاية بالنسبة للكباشة عند أجدادنا أيام زمان.
فعندما تتم خصاية الكبش فإنه تُنتزغ خصيتاه بواسطة آلة حادة لكن يبقى داخل الجلد المحيط بالخصيتين بعد قطعهما بقايا من الدم يقومون بتنظيفه بواسطة أصابع اليد حتى لايتجتمع الدم فيؤذي الكبش وقد يؤدي إلى الوفاة.
ياترى:
مااسم هذه الطريقة بالمصطلح اللهجي؟
جائزة السؤال بطاقة شحن بقيمة (10)ريال.
اسم المصطلح هو:المصر
وهوإخراج الدم المتجمع بأطراف الأصابع "الإبهام والسبابة"
وقد اتفقت اللهجة والفصحى على التسمية"مصر"
مصر (الصّحّاح في اللغة)
والمَصْرُ حَلَبٌ بأطراف الأصابع.
والمَصْرُ أيضاً: حَلَبُ كل ما في الضَرع.
والتَمَصُّرُ: حَلَبُ بقايا اللبن في الضَرع. أبو زيد: المَصْرُ من المعز خاصَّةً دون الضأن، وهي التي قد غَرَزَتْ إلا قليلاً.
وجمعها مَصائِرُ.
وقال العدَبَّسُ: جمعها مِصارٌ.
والمَصورُ: الناقة التي يَتَمَصَّرُ لبنها، أي يُحلب قليلاً قليلاً، لأنَّ لبنها بطيء الخروج.
ويقال: مَصَّرَتِ العنزُ تَمْصيراً، أي صارتْ مَصوراً.
ونعجةٌ ماصِرَةٌ، أي قليلة اللبن.
وفلانٌ مَصَّرَ الأمْصارَ، كما يقال مدَّنَ المَدائِنُ.
مصر (مقاييس اللغة)
الميم والصاد والراء أصلٌ صحيح له ثلاثة معان.الأوّل جنسٌ من الحَلْب، والثاني تحديدٌ في شيء، والثالث عُضوٌ من الأعضاء.فالأوّل: المَصْر: الحَلْب بأطراف الأصابع وناقةٌ مَصورٌ: لبنُها بطيء الخروج لا تُحلَب إلاّ مَصْراً.قال ابن السكِّيت: المَصْر: حلب ما في الضَّرع.
ويقال التمصُّر: حلب بقايااللَّبَن في الضّرع.
مَصَرَ (القاموس المحيط)
مَصَرَ الناقَةَ أو الشاةَ،
وتَمَصَّرَها، وامْتَصَرَها: حَلَبَها بأَطْرافِ الأَصابعِ الثَّلاثِ، أو بالإِبْهامِ والسَّبَّابَةِ فَقَطْ.
وهي ماصِرٌ ومَصُورٌ: بَطيئَةُ خُروجِ اللَّبَنِ
|



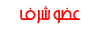

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس