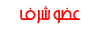فارس بن حزام
لم يبخل الإعلام في تركيز الضوء على «القاعدة» في العراق ومذابحها، فطوال الأعوام، التي قاربت على استكمال الأربعة، كان الحديث ينحصر في «القاعدة» وبقايا «البعث»، وإطلالات محدودة على الميليشيات الشيعية تنحصر في رفض وجودها والدعوة إلى إلغائها ودمجها في المؤسسة الرسمية، من دون التناول الموضوعي لما تمارسه في ميدان الواقع.
الحكاية العراقية هذه تشعبت تفاصيلها في أعقاب مقتل «أبو مصعب الزرقاوي» مطلع الصيف الماضي. أخذ الحديث يتسع ليشمل المذابح على الطرف الآخر، المذابح المضادة. بدأت وسائل الإعلام تطل باستحياء على حال كانت مغيبة. القتل المضاد في العراق ليس حديثاً، الحداثة اقتصرت على إبراز الإعلام له، فمنذ سقوط حكومة الرئيس صدام حسين، والقتل والقتل المضاد موجودان، ومثلهما معارك التهجير، والجنوب كان حاضراً بقوة في هذا المجال، عبر عمليات القتل الانتقائية، وتحويل مساجد للسنة إلى مساجد للشيعة.
كان الإعلام مداناً بما فيه الكفاية لعدم نقله الصورة الأخرى، فاقتصرت الوحشية على طرف، وظهر الطرف الآخر ضحية، فيما الشر منهج مطبق لدى الاثنين، وقوى الشر معروفة لدى أهل العراق وغيره.
قرر بعض وسائل الإعلام الأجنبية - فجأة - إلقاء الضوء على أحد «أمراء القتل المضاد»، فقدمه وفق كنيته المحلية «أبو درع»، ولم يتبحر في تفاصيله، مكتفياً بأنه يقود إحدى فرق الموت، وانه انشق عن زعيمه السيد مقتدى الصدر، زعيم جيش المهدي.
لا استسيغ كثيراً ذلك الانشقاق المعلن، فالناس باتت تعلم ما يمثله الصدر، الذي لا تقوى عليه الحكومة الحالية، بعكس حكومة الرئيس الأسبق إياد علاوي.
في التفاصيل الأخرى عن «أبو درع»، أن اسمه إسماعيل اللامي، وهو ذو أصول تعود إلى مدينة العمارة، ونشأ ويعيش في مدينة الصدر البغدادية، وله من الأبناء ستة من زوجتين، وقد قتل أحدهم في هجوم أميركي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
و «أبو درع»، القصير القامة ذو اللحية السوداء الكثة، هو أمي كذلك، فبحسب أحد الزملاء العراقيين الذي يعرفه جيداً، يقول أنه أحد خريجي الجرائم الجنائية في عهد الرئيس صدام، إذ صدرت بحقه أحكام في قضايا جنائية، قبل أن يشمله قرار العفو الذي سبق الحرب، لينضم إلى جماعة مقتدى الصدر. وعقب سقوط النظام وجد نفسه يقود جمعاً من المسلحين، يزداد أعدادهم بين فينة وأخرى.
ولـ «أبي درع» أسلوبه في القتل، كما يشاع، فالحديث اليوم عن مثقاب يخترق الجمجمة، يميز عملياته عن الآخرين. يستخدم «دريل» كهربائياً ليجهز على خصومه، قبل ان يلقي بجثثهم في حفر أحدثتها تفجيرات «القاعدة».
اليوم، يتنقل «أبو درع» بين أحياء بغداد، وصولاً إلى ضواحيها والمدن الصغيرة المحيطة بها جنوباً وشمالاً، في حماية رجاله، وبعيداً - أو قريباً - من أعين رجال أمن عراقيين، من دون أن يمسه أحد، منتقياً أهدافه من المدنيين، ومستفيداً من غزارة المعلومات التي ترد إليه، ليرسم طريقه قبل كل عملية وبعدها.
لا أرى اليوم في «أبي درع» إلا نتيجة طبيعية لحال مباركة أعمال «القاعدة» التي نعيشها طوال الحرب الدائرة في العراق. لدينا جمهور يصفق لعمليات قتل المدنيين الشيعة، ويمنح القتلة عباءات الشهادة، من دون تمييز بين قتل الجندي المحتل وقتل المواطن ابن البلد. هذا التعاطي يستوجب النظر إلى أن «أبي درع»، ومن شابهه، ليسوا إلا الوجه الآخر من العملة، وما ارتفاع شعبيته لدى أوساط طائفته إلاّ حال يجب أن تفهم وتستوعب جيداً، لأنها تأتي تحت خانة «القتل المضاد».
لكن المثير جداً، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دان الهجوم الأخير على مدينة الصدر للقبض على «أبو درع»، في الوقت الذي تشهد حكومته هجمات أميركية مماثلة على مدن سنية أخرى بحثاً عن مسلحين، لم ترق إلى درجة تدفعه لإدانتها.
من هنا، يمكن القول أن وسائل الإعلام التي تغيب «القتل المضاد»، لا تقوم بذلك إلا تماشياً مع الإدارة العراقية الحالية، ولا أعلم أين هي مكامن التأثير التي تملكها حكومة المالكي على كل هذا الكم من وسائل الإعلام.
يمكن القول أيضاً، أن وسائل الإعلام، التلفزيونية تحديداً، لا تملك القدرة على الوجود الدائم في الجنوب العراقي، الذي يقع تحت سيطرة «المجلس الأعلى للسيد عبدالعزيز الحكيم»، ولذا تغيب الصورة وتغيب المعلومة الموثقة، ولا يصدر عن الجنوب سوى تسريبات الفارين من «القتل المضاد».
في غياب وسائل الإعلام تسلق «زرقاوي الشيعة» إلى واجهة المشهد الدموي في العراق، كوجه آخر لعملة العنف. هناك كان «أبو مصعب الزرقاوي»، واليوم خليفته، واليوم هنا «أبو درع» وزميله «أبو سجاد»، وكلاهما أبناء «جيش الصدر».
من غرائب المشهد العراقي، أن قائمة الـ 41 مطلوباً، التي أعلنتها الحكومة العراقية في 2 تموز (يوليو) الماضي، ضمت اثنين من قياديي «جيش الصدر»، هما «أبو مصطفى الشيباني» و «أحمد الغروي»، ولم تضم «أبو درع» على رغم أن الثلاثة في خانة قتل واحدة. التفسير الذي يراه أحد المراقبين العراقيين، هو أن الحكومة العراقية لا تريد أن تثقل على كاهل الصدر بثلاثة.
* نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية
|



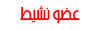

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس