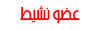هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الكرب والهم والغم والحزن
أخرجا في الصحيحين من حديث ابن عباس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب الأرض رب العرش الكريم).
وفي جامع الترمذي عن أنس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا حزبه أمر، قال: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث).
وفيه: عن أبي هريرة، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أهمه الأمر، رفع طرفه إلى السماء فقال: (سبحان الله العظيم)، وإذا اجتهد في الدعاء قال: (يا حي يا قيوم).
وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت).
وفيها أيضًا عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب، أو في الكرب: الله ربى لا أشرك به شيئًا). وفي رواية أنها تقال سبع مرات.
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وأبدله مكانه فرحًا).
وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له).
وفي رواية: (إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس).
وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري، قال: دخل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: (يا أبا أمامة مالي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، فقال: ألا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب الله ـ عز وجل ـ همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال)، قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله ـ عز وجل ـ همى، وقضى عني ديني.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (من لزم الإستغفار، جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب).
وفي المسند أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا حزبه أمر، فزع إلى الصلاة، وقد قال تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة} [البقرة: 45].
وفي السنن: (عليكم بالجهاد، فإنه باب من أبواب الجنة، يدفع الله به عن النفوس الهم والغم).
ويذكر عن ابن عباس، عن النبي ـ صلى الله على وسلم ـ: (من كثرت همومه وغمومه، فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله).
وثبت في الصحيحين (أنها كنز من كنوز الجنة).
وفي الترمذي: (أنها باب من أبواب الجنة).
هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعًا من الدواء، فإن لم تقو على إذهاب داء الهم والغم والحزن، فهو داء قد استحكم، وتمكنت أسبابه، ويحتاج إلى استفراغ كلي.
الأول: توحيد الربوبية.
الثاني: توحيد الإلهية.
الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادي.
الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده، أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك.
الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم.
السادس: التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء، وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحي القيوم.
السابع: الاستعانة به وحده.
الثامن: إقرار العبد له بالرجاء.
التاسع: تحقيق التوكل عليه، والتفويض إليه، والإعتراف له بأن ناصيته في يده، يصرفه كيف يشاء، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه.
العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات واللهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره، فيكون جلاء حزنه، وشفاء همه وغمه.
الحادي عشر: الاستغفار.
الثاني عشر: التوبة.
الثالث عشر: الجهاد.
الرابع عشر: الصلاة.
الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده.
فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض
خلق الله ـ سبحانه ـ ابن آدم وأعضاءه، وجعل لكل عضو منها كمالًا إذا فقده أحس بالألم، وجعل لملكها وهو القلب كمالًا، إذا فقده، حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان.
فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها.
والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به، والإبتهاج بحبه، والرضى عنه، والتوكل عليه، والحب فيه، والبغض فيه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه، وارجي عنده من كل ما سواه، وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة، بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه، ورهن مقيم عليه.
ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوب والغفلة والإستهانة بمحابه ومراضيه، وترك التفويض إليه، وقلة الإعتماد عليه، والركون إلى ما سواه، والسخط بمقدوره، والشك في وعده ووعيده.
وإذا تأملت أمراض القلب، وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها، فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرض يزال بالضد، والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية، وأمراضه بأضدادها.
فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه، وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب الشرور، فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار.
قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم، فليقلل من الطعام والشراب، ومن أراد عافية القلب، فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام.
|




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس