بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كنت أتصفح الموسوعة الفقهية الكويتية فوقع نظري على كلمة ملاءة وما تحتها من تفصيلات فأحببت أن أفيد بها إخوتي في الله وهذا موضوع فقهي في الدرجة الأولى وهاهي المعلومات نقلا من الموسوعة
مَلاءة *
التّعريف :
1 - الملاءة في اللغة : مصدر الفعل مَلُؤَ - بضمّ اللّام - قال الفيومي : مَلُؤَ - بالضّمّ - ملاءةً , وهو أملأُ القوم أي : أقدرهم وأغناهم , ورجل مليء – مهموز - على وزن فعيل : غنيّ مقتدر .
وفي لسان العرب : رجل مليء : كثير المال بيّن الملاء , والجمع مِلاء , وقد ملُؤَ الرّجل يملُؤُ ملاءةً فهو مليء : صار مليئاً , أي ثقةً , فهو غنيّ مليء : بيّن الملاء والملاءة .
وقد أُولِع فيه النّاس بترك الهمز وتشديد الياء .
وفي اصطلاح الفقهاء : الملاءة : هي الغنى واليسار .
وقد فسّر أحمد الملاءة فقال : تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن , فالمليء هو من كان قادراً بماله وقوله وبدنه , قال البهوتي : وجزم به في المحرّر والنّظم والفروع والفائق والمنتهى وغيرها , ثمّ قال البهوتي : زاد في الرّعاية الصغرى والحاويين : وفعله , وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء .
فالملاءة في المال : القدرة على الوفاء , والملاءة في القول : أن لا يكون مماطلاً .
والملاءة في البدن : إمكان حضوره مجلس الحكم , قال البهوتي : هذا معنى كلام الزّركشيّ. ثمّ قال : والظّاهر أنّ : " فعله " يرجع إلى عدم المطل إذ الباذل غير مماطل .
و : " تمكنه من الأداء " يرجع إلى القدرة على الوفاء , إذ من ماله غائب أو في الذّمّة ونحوه غير قادر على الوفاء , ولذلك أسقطهما الأكثر ولم يفسّرهما .
الألفاظ ذات الصّلة :
الإعسار :
2 - الإعسار في اللغة : مصدر أعسر , وهو ضد اليسار , والعسر : الضّيق والشّدّة , والإعسار والعسرة : قلّة ذات اليد .
والإعسار في الاصطلاح : عدم القدرة على النّفقة أو على أداء ما عليه بمال ولا كسب , أو هو زيادة خرجه عن دخله .
والإعسار ضد الملاءة .
ما يتعلّق بالملاءة من أحكام :
يتعلّق بالملاءة أحكام منها :
أ - أثر الملاءة في زكاة الدّين :
وسنكمل الموضوع إن شاء الله تعالى
|



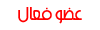

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


