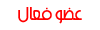الحضارة تضربها أزمات بقلم: أ.د. نعمان السامرائي
الأحياء كافة تمرض وتموت، أما الحضارة وهي منجز إنساني فتضربها (أزمات) ثقيلة وخفيفة، وطويلة، فمتى جرت معالجة الأزمات بسرعة وبعلاج ناجع تتعافى الحضارة وإن طالت الأزمة أو كان العلاج غير مجد ولا نافع فقد تنهار الحضارة، هذا القانون يسري على كافة الحضارات، مؤمنها وكافرها، قديمها وحديثها..
حضارة اليوم ليست بدعاً ولا تشكل استثناء وإن اعتقد أهلها ذلك، حتى ذهب توينبي صاحب (التفسير الحضاري) إلى أن حضارة اليوم لا تتمتع بنوع من (الإرجاء) يمكنها من البقاء... وإن كان يؤمن بأن الحضارات تمر بأدوار من النمو إلى الشيخوخة حتى السقوط والانهيار، وله في (السقوط) توصيف جيداً - سيأتي -.
د. عبدالوهاب المسيري - رحمه الله - وهو من فرسان هذا الميدان - تحدث عن أزمات الحضارة الحاضرة فرأى: أنها دخلت مرحلة (الأزمات) منذ نهاية القرن (91) حتى فقدت كثيراً من ثقتها بنفسها، فظهرت أدبيات تعبر عن هذه الأزمة يمكن تسميتها بـ(الفكر الاجتماعي أو المضاد) ويرجع هذا إلى عصر النهضة في الغرب، أي مع ظهور النموذج (النفعي المادي) لكنه ظل متوارياً بسبب انتصارات الحضارة الغربية المادية والمعنوية، لكن مع دخول هذه الحضارة مرحلة (الأزمة) ومع تزايد فقدانها الثقة بنفسها، راح الفكر الاجتماعي يكتب مزيداً من المركزية والمصداقية... وقد حاول هذا الفكر (وصف الأزمة) والتعبير عنها، بل تجاوزها، وهنا لا بد من الاستفادة من هذا الفكر ومحاولاته استرداد (المنظور النقدي) تجاه الحضارة الغربية، ولا بد أن توفر للقارئ العربي أهم أدبيات هذا الفكر، الذي يشمل كل فروع المعرفة مثل النقد الأدبي وعلم اللغة والفلسفة وعلم البيئة والعلوم الطبيعية والتاريخ... إلخ.
وسنجد أن النموذج الكامن وراء هذا (الفكر) ينطوي على قدر من (الرفض) للنماذج العلمية المادية العامة، التي تهمل الكيف وما لا يقاس والمطلقات والخصوصية.
إن وجود هذه الأدبيات باللغة العربية سيجعل الحوار بخصوص المشروع الحضاري الغربي أكثر (تركيباً)(1)...اهـ
إن الأزمات بالنسبة للحضارة هي أمراضها، وكما تختلف الأمراض قوة وضعفاً كذلك الأزمات، والإعصار الأمريكي الأخير منها!!!...
يلاحظ في البداية تكون للحضارة (قوة ومرونة) تمكنها من معالجة الأزمات والتغلب عليها، لكن حين تشيخ الحضارة تضعف قابليتها للعلاج وللمقاومة، والظاهرة تشبه ما يتعرض له الإنسان، فالأمراض التي تصيب الإنسان في شبابه وقوته يسهل علاجها، لكن ما أن يشيخ الإنسان فإن موجة (برد) مثلاً قد تجعله طريح الفراش أياماً وليالي، وكان بالأمس يمر بها بسهولة.
وعودة إلى (فارس) آخر هو (توينبي) وقد كتب تاريخ العالم، وأقام تفسيراً أطلق عليه (التفسير الحضاري) والذي يهمنا هو نظريته التي أسماها (التحدي والاستجابة) وملخصها: أن الإنسان منشئ الحضارة يخضع في تحركه لقانون (التحدي والاستجابة)، فالتحدي يحركه بشرط ألا يكون قوياً جداً ولا سهلاً كذلك(2).
وحجته أن التحدي السهل لا يثير الإنسان، وأما القوي فيعجزه ويذكر مثلاً للتحدي السهل: العيش في المناطق الاستوائية، حيث الجو المعتدل المشمس الماطر فلا يخشى الإنسان أن يموت جوعاً أو عطشاً أو يموت بسبب البرد الشديد أو الحرارة العالية.
وأما التحدي القوي القاسي فلا يملك معه الإنسان حيلة كمن يعيش في صحراء لا ماء ولا حياة أو يعيش في المناطق القطبية فتكون حياته مجرد صراع كي لا يموت من البرد..
وهنا يمكن القول إن صعوبة وسهولة التحدي نسبية تختلف من شعب لآخر بحسب ثقافته وعزمه على فعل شيء.
أما ما كتبه عن سقوط الحضارات فأحسبه قد وفق كثيراً، إذ يردها إلى ثلاثة أسباب أساسية(3):
1- ضعف القوة المبدعة في الأقلية الموجهة، وتحولها إلى سلطة تعسفية، همها المحافظة على مراكزها ومصالحها.
2- تخلي الأكثرية عن موالاة الأقلية المسيطرة مع الكف عن تقليدها، وحصول الانشقاقات والصراعات.
3- ضياع الوحدة، حيث تقف الأكثرية ضد الأقلية المسيطرة دون وجه حق وعندها تسقط الحضارة وتنهار..
عندما ينتشر الفساد
هنا يتحدث توينبي فيبدع، حيث يرى أن انحلال الحضارة يرافقه عادة انتشار (الفساد) الذي يدب في (أرواح الناس)، وتغير جذري في السلوك، يتعمق حتى يصل إلى المشاعر، بل كافة جوانب الحياة، عندها تقوم مكان الصفات الجيدة، والقوى المبدعة، التي كانت تطفح بها النفوس في دور (النمو) فيحل مكانها (ثنائية) من النزعات والمواقف العقيمة، بل المتضاربة والمتناقضة، وساعتها (يتعرى الفساد) الروحي وينكشف عن فوضوية تشمل الأخلاق والعادات، وانحطاط يسود الآداب والفنون، مع محاولات عقيمة للتوفيق والتلفيق بين الديانات...اهـ
رؤية واضحة وقراءة عميقة لسقوط الحضارة، تصدق على أكثر من حضارة واحدة، ونهاية محزنة لا تدل عليها البدايات الجيدة الجادة.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) العالم من منظور غربي/ كتاب الهلال ص(332) عام 002م.
(2) للكاتب مؤلف عنوانه تفسير التاريخ ص(111) لعام 7241هـ.
|



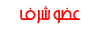

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس