الشيخ سليمان الماجد قاضي المحكمة الكبرى وعضو مجلس الشورى:التعامل مع المخالف.. فقه يحتاج إلى فقه!
من سنن الله تعالى في خلقه أن جعلهم مختلفين في أشياء كثيرة: في ألسنتهم وألوانهم، وفي طبائعهم وميولهم النفسي والعقلي والعاطفي، وفي آرائهم ونظراتهم في الدين والنفس والمجتمع وما يحيط بهم، وكان ذلك لحكم عظيمة من أوضحها: الابتلاء والامتحان؛ ليظهر من يُعَظِّم الحق ومن لا يُعَظِّمه، وليُعرف ـ أيضاً ـ جزاء العاصي والمطيع، وشحذ العقل للمزيد من التدبر والتأمل في القرآن والنفس والآفاق.. حول فقه التعامل مع المخالفين يدور حوارنا التالي مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والقاضي بالمحكمة الكبرى
* في البدء ما مفهوم المخالف وما الأثر المقصدي والشرعي لفقه الخلاف؟
- المخالف هو كل من خالفك في أي شيء؛ فهو الوثني والملحد والكتابي والمرتد والمنافق والمبتدع بدعة اعتقادية والمبتدع بدعة عملية، وهو المنازع في المسائل الفقهية القطعية والظنية، وكذلك في المناهج المختلفة، سواء كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو في أي صعيد. فكل من لا يرى رأيك أو عملك فهو لك مخالف.
وكل هؤلاء المخالفين ينبغي أن يعاملوا بقواعد العدل التي دلت عليه الشريعة.
وأما الأثر المقصدي والشرعي لفقه الخلاف فإنه إذا تحقق فقه الخلاف كما أراده الله تعالى فإن لذلك آثاراً عظيمة في النفس والمجتمع؛ فمنها: تحقيق العبودية لله حيث يتحقق بإحياء فقه الخلاف أشرف المعاني، وأجل المقاصد وهو توحيد الله، وتمام العبودية له جل شأنه في خطرات الإنسان، وتفكيره تجاه الآخرين، وفي تعامله معهم، كما يحصل به التمحيص والامتحان فالخلاف مضيق لآراء الناس ومواقفهم، وعند المضايق يذهب اللب، وإذا ذهب اللب فلا تسأل عن ضياع حقوق المخالف؛ بل ضياع الحق نفسه في أحيان كثيرة.
فالرأي الذي يعلنه الشخص مرآة لعقله وفكره أو أتباعه أو متبوعيه، والسائد عند كثير من الناس أن المخالفة والنقد انتقاص لعقله وتسفيه لرأيه وعدوان على محبيه، وحينئذ يبدأ العدوان على المخالفين.. وهو عدوان ظاهره فيه الرحمة: محبة الحق، وباطنه فيه العذاب: محبة النفس والانتصار لها، ومن حكم الاختلاف بعث التفكير، ونفض غبار التقليد تحقيق الألفة، وقطع أسباب الشحناء وحين ضاع فقه الاختلاف نهاية القرن الثالث ظهرت آثار مدمرة من الشحناء والعداوات انقشعت أغبرتها على ضياع المصالح، وتسلط الأعداء، وكان من أبرز مظاهر هذه العصور الضعف السياسي والاقتصادي والعلمي والعسكري.
وكان من آثاره على الصعيد الجهادي أنه لم تفتح في هذه الحقبة بلدان جديدة؛ بل صار أكثر عمل الجند رد هجمات الأعداء، أو الارتماء في أتون الحروب الداخلية.
وقد قال الإمام ابن تيمية بعد ذكر الخلافات العقدية: (.. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها، وحكامها وكبرائها، هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها.. وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا أصلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب).
ومن حكم الاختلاف تحقيق المقاصد في شمول وإتقان، فإن تضييع فقه الاختلاف ينتج عزلاً لأهل المنهج الحق وتناقصاً في قوة نفوذهم وسلطانهم.
وحين يأخذ المرء لمحة تاريخية لآخر القرن الثالث الهجري يرى أن الناس حين بدأوا بإهمال مقومات هذا الفقه؛ كمخاطبة العواطف والقلوب من خلال الرقائق والإيمانيات، واستخدام الرصيد الأخلاقي في التعامل مع الناس؛ كالحلم والتواضع والصبر وطلاقة الوجه، واستعمال السياسية الشرعية، واعتبار قواعد المصالح والمفاسد، والتعاون مع السلاطين، واحتمال المفاسد الدنيا لأجل المصالح العليا حتى بدأت الآثار تظهر بعد تصرم القرون المفضلة ضعفاً وتشرذماً، وعلى إثر ذلك حتى بدت النتائج المرة: ظهور الشرك الأكبر بالطواف على القبور والأضرحة ودعاء غير الله؛ مما لم يكون موجوداً في القرون الأولى، وكان لأهل السنة قوة ظاهرة وتأثير في المشهد العام.
ولكن لا زالوا يعرضون عن هذه الأمور، أو يهملونها؛ فما أطل القرن التاسع إلا وقد صارت البدع العملية والاعتقادية المخالفة لمنهج القرون المفضلة ظاهرة لا يمكن إنكارها، واكتسح المخالفون لهذا المنهج من الغلاة الشارع العام، واستمرت الحال منذ ذلك القرن، إلى حين قيام الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بدعوته الإصلاحية التجديدية؛ فأحيا رحمه الله ما اندرس منه، وجدد ما عفا.
وقد ترسخ عند العامة بسبب حالة القحط في المنافحين عن هذا المنهج في هذه الحقبة، وبسبب قلة الأتباع وانتشار البدع ترسخ عندهم أن ما عليه العالم الإسلامي من هذه المفاسد الكبرى هي الحال التي كانت عليها القرون المفضلة.
* ولكن واقع الحال الآن يشهد اشتداد التطاحن بين فرق أهل السنة وعودة التراشق بين تياراتها؟
- في التاريخ المعاصر ومنذ الانطلاقة الأولى للصحوة المعاصرة، وما جاء بعد انطلاقتها بقليل من توجهها إلى العناية بعقيدة القرون المفضلة بالمنافحة عن هذا المنهج والتفرغ له ـ وقد أحسنوا في هذا ـ إلا أن حالة الحماس والنشوة التي ترافق قيام الحركات بأنواعها أذهلتها عن تقويم التجربة التاريخية القديمة في التعامل مع البدع التي استقرت وقوي أصحابها؛ فكان بينهم وبين مخالفيهم نوع من المنافرة والمفاصلة والشدة، وإن لم تصل إلى ما كان في عصور الانحطاط الغابرة.
وبالنظرة السريعة إلى هذه التجربة خلال الثلاثين عاماً الماضية يرى إهمال هذا الفقه باتباع منهج التنفير لم يغير في خرائط الانتماءات إلى المناهج الأخرى؛ فبقي كل على منهجه وطريقته، والذي بقي في اليد بعد هذه التجربة حنظل من الإحن وعلقم من العداوات؛ فيما لم يتحقق اختراق يذكر لهذه الاتجاهات، والمكاسب القليلة التي قد نجنيها من هذا المنهج لا تسوغ تلك القطيعة.
بل حمل ذلك بعض غلاة المخالفين إلى البحث عن هوية كاد ينساها؛ ليعود إلى إحيائها مكايدة لمن نافره وقاطعه.
أمثلة لعدم التثبت
* يتطلع القارئ إلى نماذج لأحكام ترون أن الناس لم يتثبتوا فيها التثبت الشرعي؟
- نعم، مثلاً التفريق في التعامل مع المخالف بين مسائل الفروع والأصول، فقد جعل بعضهم الفروع والأصول، أو العقائد والفقهيات هي المفرق لما يسوغ فيه الخلاف، وما لا يسوغ، وبنوا على ذلك أحكاماً في التكفير، بل واستحلال عقوبته، أو حتى قتله. وهذا التفريق بدعة أحدثها المخالفون لأهل السنة، وجعلوها سيفاً مصلتاً عليهم؛ لحملهم على أن يأخذوا بقولهم؛ فاستعدوا عليهم السلاطين، وعزلوهم بسببها من وظائفهم، وجردوهم من إمامة الناس في الصلاة، والتدريس والفتوى والوعظ.
ومنه اعتبار مسائل البدع العملية من قضايا الاعتقاد: ولو سلمنا بالتفريق بين مسائل الفروع والأصول، والقطعية والظنية فإن مسائل البدع العملية التي يختلف فيها الناس، وتبنى على الاستنباط هي من مسائل الفقه والظن لا من مسائل القطع واليقين، وتكون في أبواب الفقه، وليست في أبواب العقائد، وعلى التسليم بالفرق فإن محل مصنفات البدع العملية هو قسم الفقه وليس قسم العقيدة.
والبدع العملية هي التي تكون في الصلوات؛ كدعاء ختم القرآن فيها، والأذكار؛ كالذكر الجماعي، والأعياد؛ كالمولد واليوم الوطني، وتعليق التمائم من القرآن، والتعريف في الأمصار.
ومن الأمثلة عدم التفريق بين الفعل وفاعله، فالفعل وإن كان يُسمى كفراً بيقين فلا يجب الحكم على الفاعل بالكفر، وإجراء أحكامه الظاهرة مادام متأولاً في ذلك، أو مستتراً به، أو متنصلاً مما نُسب إليه. ولا يعني هذا منع أو تحريم إلحاق الوصف به؛ بل يجوز ذلك، عند تحقق الشروط، وانتفاء الموانع، وظهور الحجة التي يكفر منكرها، وهذا إنما يكون للحاكم، وليس لآحاد الناس.
وقد أخطأ في ذلك كثير من الناس فظنوا أن تكفير المعين هو مثل معرفة الكفر والحذر منه؛ فمن لم يُظهر تكفير من فعل كفرا أو قاله فقد فرط في حق الإيمان؛ بل غلوا في ذلك؛ فرأوا أنه لا يصح لهم إيمان إلا بذلك.
والناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يظهر بجلاء أنه لم يقم أحكام الكفر على من ظهر منه ذلك سواء كان من المؤمنين؛ كحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين وُجدت منه مظاهرة للمشركين على المؤمنين؛ بل إن آية البراء من المشركين التي كُفِّر به كثيرون قد نزلت فيه رضي الله عنه، أو كان من المنافقين الذي بدت منهم مقالات الكفر؛ كقولهم: ليخرجن الأعز منها الأذل، وكقولهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل.
وقد أورث الخطأ في تأصيل هذه المسألة أحكاماً جائرة بالكفر، وظلماً للمخالفين بوصف المعين منهم بالمبتدع، حتى صرنا نسمع من البعض وصف من تلبس ببدعة عملية بأنه مبتدع فتراهم يقولون: جاء المبتدع وذهب، ويقولون للمعينين: أولئك المبتدعة. ومثل ذلك الحكم على المعين بأنه هالك، أو أن الطائفة المعينة هالكة بمجرد قول أو فعل.
والحكم بالهلاك على المعين هو كالحكم بالكفر لا بد له من اجتماع شروط وانتفاء موانع. والمقصود من حديث: كلها في النار إلا واحدة هو تبيين أسباب الهلاك؛ ليحذرها الناس لا أن تُطبق على المعين.
تلمس العذر
* وما الأساس الشرعي في تلمس العذر للمخالف.. وكيف يمكن ضبط هذا العذر؟
- المعذرة ينبغي أن تُعتبر في الحاكم على الناس بأي حكم، وكذلك في المحكوم عليه، أما في الحاكم فظاهر؛ حيث ينتفع بذلك في اعتبار معذرته، وأما في المحكوم عليه فينبغي أن يعذر الحاكم عليه؛ مادام مجتهداً متحرياً للحق. وقال الإمام ابن تيمية في "الفتاوى": وإن كان المخطئ المجتهد مغفورًا له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب؛ وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله.
وأسباب هذه المعذرة كثيرة؛ فمنها: الحسنات الماحية:
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "الاستقامة" (1/297) عن الغناء الصوفي: "والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم.. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة"
* وكيف ترون إطلاق الوصف بالكفر على أتباع فرقة ما أو أهل مكان ما بالعموم؟
- لا يجوز أن يحكم على المعين بما يُنسب إلى طائفته أو بني قومه، فلا يجوز أن يكفر أحد من أهل القبلة بمجرد انتسابه إلى فرقة تكون منظومةُ عقائدها أو بعضها كفراً؛ بل إن هذا ظلم تأباه أصول الشريعة؛ لأن مقتضى هذا العدل أن نبقى على اليقين، وهو إقرارهم ظاهراً بالشهادتين، والا يؤاخذ المرء إلا بما أظهره هو نفسه مما يخالفها من قول أو فعل.
ومثال ذلك أهل الملل التي يُعلم بالضرورة أن المقالات التي يقولونها والعقائد التي ينتحلونها شرك أكبر في توحيد الربوبية والإلهية، أو إلحاد في الأسماء والصفات؛ ولكن بعض المخالطين لهم يأخذون الحكم بالعموم؛ ليكون حكماً على كل منتسب إلى هذه الملة؛ بل يجرون أحكام الكفر بمجرد اسم الشخص الذي يكثر في أهل هذه الفرقة، أو بمجرد اسم عائلته، أو بلدته. فمن شرط تكفير المعين اعتراف الشخص به، وأنه يبعد أن يحصل هذا الاعتراف، وأن التكفير لا ينكر إذا حصل شرطه، وأنه لا يكفي في ذلك أن يقال: هذا من تلك الفرقة وإن كان يُحكم من حيث الجملة على من اعتقد بمكفر أنه كافر، فالواحد المعين من أتباع الطرق التي عرف من أئمتها وكتبها كفر في الربوبية أو الإلهية وأقر بانتسابه إلى هذه الملة أو تلك الطريقة، ولم يظهر منه المكفِّر المعين فالأصل ألا تُجرى على أحد منهم أحكام الكفر إلا بعد اليقين أن القول أو الفعل الصادرين منه يعدان كفراً، وأن المعين قد فعله بنفسه، وأن الحجة قد قامت عليه، وإلا استبقينا لهذا المعين صحة إسلامه.
منهج الاعتدال
* وما السبل التي يشرع الالتزام بها لتطبيق مبدأ العدل والإنصاف مع المخالف؟
- أولها التمسك بفضيلة العدل، بتحصيل العلم الشرعي؛ فتحقيق المسائل التي يُحكم بها على الآخرين ضروري لتحقيق العدل مع الناس، ومن قصّر في تحصيله فليس بمعذور أن يحكم أو يتعامل مع أحد بمعاملة يكرهها.
ومنها: التأني، وأن يجعل للزمن مجالاً قبل الكلام في حق شخص أو مؤسسة. والعلم بواقع الحال، من معرفة حال الشخص الذي نتعامل معه، أو نحكم عليه من ناحية علمه وجهله بما فعله، والأسباب والدوافع لذلك الفعل، وأسباب المعذرة، ومعرفة ما لديه من حسنات قد تغمر ما بدا منه من خطأ أو زلل. واتهام النفس؛ فإنه بداية تلمس أسباب العدل، والوقوف على ما يعين عليه، ومتى كان المرء مزرياً على نفسه متهماً لها، يتوقع منها الخلل والزلل والهوى كان أبعد الناس عن الوقوع في الظلم والعدوان. وأن ينظر إلى أعماله السابقة، وأحكامه السالفة، وكذلك أحوال الظلمة؛ فكثير من الناس يكون جوره وظلمه بسبب توتره واضطراره إلى علاج الحالة في ضيق من الزمان أو المكان، أو ضغط الأحوال والأشخاص الذين يحيطون به. والشجاعة الأدبية مع من يخافهم أو يحبهم أو يرجوهم؛ فهو قوي شجاع عند تكبير محبيه أو شماتة أعاديه؛ فإن جرب من نفسه ضعفاً عندها وخوراً في مواجهة ذلك فهو محل للحيف والظلم؛ فليكن على حذر. وتصور آثار الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة. وأن يجعل نفسه مكان من يتعامل معه أو يحكم عليه؛ فإذا كان في مكانه أراد منه في معاملته أو حكمه أن يكون قائماً بالقسط مستكملاً أسباب العدل؛ فإذا استشعر ذلك كان هو معه كذلك.
وأن يحمل كلام المخالف على أحسنه، فالكلام ملك لصاحبه، وهو أولى الناس بتفسيره، وما دام أنه حمَّال أوجه لم يجز أن نختار منها ما نشاء للحكم عليه؛ لا سيما والمرء في سعة من الحكم عليه؛ فليس التعامل معه بالدرهم والدينار، ولا في مصاهرته، وإنما هو حكم أو وصف لا يحتاج إلى أن يتكلم بهما.
وأما الرد والبيان فلا يمنع منه كون الكلام محتملاً؛ فلو خشي أحد من تأثير كلامه فلينكر ذلك مع الاحتراز له بأن يقول: إن كان المعنى المقصود كذا فهو حق وإلا فهو باطل، ونحو ذلك. ومن سبل الإنصاف ألا يفجر في خصومته، فمهما بلغ المخالف في مخالفته فلا يجوز أن يظلم أو يجار عليه، أو أن يُكذب عليه، أو أن يُزاد في حديثه ما لم يقله. وأن يقارن خطأه بخطأ غيره ممن عذره، فإن كان خطؤه مثله أو قريباً منه، وكان في ظروف مماثلة، وقد عذرنا غيره؛ فلتسعه المعذرة أيضاً، ولا تكن المعاصرة، أو كون المخالف مقدما عند طائفة حاضرة سبباً للكيل بمكيالين.
وأن يعتبر حسناته، ويوازنها بسيئاته، فمن قواعد التعامل مع المخالفين أن يُنسب الفعل الذي خالف فيه إلى بقية أعماله الأخرى؛ فإن غلب خير الشخص على شره كان الحكم للغالب، وكان الحكم الجملي عليه بذلك.
التصنيف المسبق
* وماذا عن تصنيف الناس لبعضهم مسبقاً، وربط المواقف والآراء بهذا التصنيف فكرياً كان أو عقدياً؟
- من سبل الإنصاف ألا يخضع المرء تعامله مع المخالفين لتصنيف مسبق، فقد صار عسيراً على كثير من الناس أن يرى إنساناً آخر، أو يسمع به فضلاً عن يدخل معه في حديث أو علاقة بله أن يختلف معه إلا رأيته في سر أو علن يبحث عمن يكون هذا الشخص؟.. في توجهه.. في تاريخه.. في جغرافيته؛ ليجعل من هذه التصنيفات أساساً للحكم عليه والتعامل معه؛ ليس ذلك لفهم النفسيات ومحاولة الوصول إلى حلول لمشاكله؛ وإنما لأسباب غير مفهومة؛ حتى صارت هذه التصنيفات قيوداً في حركة المصنِّف عن الانطلاق مع الآخرين، وعشىً في الرؤية؛ بما ينتهي ظلماً في التعامل، وجوراً في الأحكام.
ولهذا لا يتحقق تمام العدل مع المخالف إلا بالتخلص من هذه العادة النفسية البئيسة؛ وذلك لننتفع من الخلق وننفعهم بعيداً عن أي صوارف أو مؤثرات. نعم قد نحتاج إلى بعض المعلومات عن شخص ما لتزويجه أو توليته إذا كان لآرائه أو خلفياته تأثير عليه في ذلك، لكننا لا نحتاج إلى ذلك في غير هذه المسائل. كثيراً ما يخيل للبعض أنه يكون بذلك ذكياً فطناً ينتفع بهذه المعلومات في علاقته معه، وهذا قد يكون حقاً في بعض الأحيان، ولكن الأذكى هو من احتمل بعض الخسائر في ذلك ليحصل مصالح أعظم، يحلق بها في فضاء مفتوح، ويعدو معها أفق ممتد، بعيداً عن الظنون والتهم. وليحذر المرء أن يذهب لبه وديانته حين يرى حمى التصنيف، وفوضى التهم، والالتفاف حول الهويات المتنوعة؛ فيحمله ذلك على خوض هذا الغمار، والدخول تحت ذلك الغبار.. هذا ومن أعظم الجور في التصنيف أن نتخذ الموقف، ونتعامل مع المخالف بما لم يقله هو أو يفعله، وإنما بقول غيره أو فعله.
ومن الجور في التعامل مع المخالف أن يخضع المرء في تعامله معه لتصنيف بحيث ينظر إلى الآخرين من زاوية مذهبه وحزبه وإقليمه؛ حتى لو لم يصنف هو أحداً؛ فلن يكون عادلاً منصفاً إلا إذا جعل ميزان الحكم على الآخرين والتعامل معهم بناء على ما يقولون ويفعلون مجرداً من أي تأثيرات أخرى، وبحسب الأدلة والقواعد، وإلا سلك طريق الظلم والعدوان دون أن يدري، وإن كان ديناً صالحاً. وأخطر ما في التصنيف هو: حين يُرسخ عند الأتباع؛ أن المصنَّف شيء "آخر"، ونوع "مختلف" حتى صار البعض يشك في تدينه وتألهه وقصده، وصار الناس يسمعون نحواً من هذه الكلمات: رغم أنه.. إلا أنه، ونحو: ومع أنه كذا فإنه يحافظ على كذا؛ فكان الصلاح والاستقامة لا تكون إلا له، فيا لله ماذا فعلت الفرقة بأمتنا؟
* ألا يمكننا الإفادة من القواعد الشرعية الكبرى التي تحكم سلوك المسلم في تعامله مع الآخرين عموما؟
- لاشك في أن بعض قواعد الشريعة العامة يعالج بعض الحالات الخاصة بصورة استثنائية، وذلك مثل قواعد تعارض المصالح والمفاسد، فيعتبر اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، فلا يظهر في مكان عملاً في مسألة قد استقر الناس على خلافها بحجة أن الخلاف فيها سائغ؛ فإن هذا مما يزيد الخلاف ويوسع الشقة بين المسلمين؛ كإظهار المولد في مكان أطبق الناس فيه على عدم شرعيته، لكن معرفة درجة الخلاف ينفع في معذرة المتأولين في مكان آخر، وألا يمتحن المخالف في معتقده فقد كان السلف يرون امتحان المرء لإخراج مكنونات معتقداته من البدع.
أن الممتحِن بإظهاره قول المبتدع يُكوِّن أتباعاً، أو مستمعين لصاحب البدعة؛ بل ومعجبين بطريقته؛ فكان رضاه هو بعدم إعلان خواطره خيراً من امتحانه، وإظهارها للناس.. وهذا يختلف عن البحوث العلمية والكتب التي تتخصص في عقيدة عالم معين؛ إذْ إن هذا عمل علمي يراد منه جمع آرائه وتنسيقها وموازنة القواعد الجامعة لكلامه؛ فهذا عمل علمي لا يقل نفعا وفائدة عن مصنفات تبحث في فقه إمام معين؛ فلا وجه لتحسس البعض من هذا المنهج. ومما لا يغيب عن فطنة الحكيم أن المجتهد في تعرية المخالفين ينبغي أن يعامل بهذه القواعد من خشية الله فيه ومعذرته والعدل معه والتلطف في معاملته؛ بما نصل به إلى تحقيق العبودية لله وحده. لا أن يفيد من هذه القواعد الضلالُ والمنحرفون، ولا يفيد منها القانت العابد الذي نذر نفسه محتسباً للشريعة، مدافعاً عن الدين.
ومع إصابة كثير ممن نعرفهم في هذا انتهاج طريقة التعرية؛ لا سيما مع دعاة التغريب والمنادين بسلخ الأمة عند دينها فإن ما أخطأوا في تطبيقه لا يخلو من فائدة يقع بها زجر العابثين بثوابت الأمة. والطريق الصحيح لتصحيح هذه الأخطاء في هذا المعترك الحامي، وفي مفترق هذه الطرق المضلل حماية جانبهم؛ لكثرة صوابهم، مع تنبيههم إلى ما أخطأوا أو بالغوا فيه.
التعامل مع المخالف
* وماذا عن المشروعات المشتركة ومسألة التعاون مع المخالف على ما فيه خير ونفع؟
- يجوز التعاون مع المخالف على وجوه البر إذا غلبت مصلحة ذلك حيث تقرر أن العلاقة مع المخالفين ـ بما فيهم المبتدعة ـ مبناها على قواعد المصالح والمفاسد فإن هذا لا يقتصر على العلاقة السلبية وهي الهجر أو عدمه، وإنما يتجاوزه إلى العلاقة الإيجابية البناءة، وهي التعاون معه على وجوه البر؛ بما لا يؤثر على القاعدة الكلية في اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذه ليست خاصة بالمبتدع، وإنما تنتظم كل مخالف.
وأخطأ قوم فجعلوا مسألة التعاون مع المبتدع ممنوعة في كل حال على كل شخص، بناء على اعتقادهم أن سبب المنع نص يحرم ذلك؛ كنص تحريم الكذب والغيبة، والصحيح ما تقرر في هذه الورقة من أن ذلك مبني على السياسة الشرعية وقاعدة المصالح والمفاسد؛ فما أنتجه إعمالها وجب العمل به والمصير إليه، ولا يختص التعامل مع المبتدع بذلك؛ بل هو شامل لكل ما لم يرد فيه نص بالمنع أو الإباحة، وحصل فيه التعارض بين المصالح والمفاسد عند العمل به.
وأكثر ما يشتبه هنا ما يراه البعض من أن في التعاون مع المخالف تزكية له، وإضفاء للشرعية على أعماله؛ مما ينتج دعماً لبدعته وتكثيراً لسواده. وهذا قد يكون حقاً في بعض الأحيان، ولكن لنحذر هنا أعظم الحذر من الأوهام التي تغذيها المعاني الترابية من حزبية أو إقليمية أو تاريخية رسخها ترك النظر والاستدلال؛ فهو أعظم ما يحجب عن رؤية الحقيقة في هذه المسائل؛ لاسيما وأنها مسائل تقديرية، ومن ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين إلى القتال مع المؤمنين، حيث خلدها القرآن على لسان عبدالله بن حرام رضي الله عنه حين قال: "قل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا" وقد قال المفسرون: إن لم يكن خروجكم جهاداً في سبيل الله فمن أجل الدفاع عن المدينة، والمعتبر هنا هو قاعدة المصالح والمفاسد، ولو قيل: إن هذا كان لحفظ بيضة المدينة أن تستباح، قيل: إن هذا من رعاية المصالح؛ إذ لو كان ذلك مبدأ لا يتغير بتغير الأحوال وجب ترك التعاون معهم؛ ولو ذهبت به النفوس والأوطان؛ فإن الله ناصر دينه ومعل كلمته.
وإذا لم يحصل تعاون ولا نصرة فلا أقل من أن نستشعر خطر الخلاف، وآثاره المدمرة؛ فيكف المرء عن التنفير والحرب والعرقلة التي توجب فساد الأحوال وتعثر الأعمال، وفساد ذات البين؛ فالمشروعات إن لم تسر متحدة فلا أقل أن يكون سيرها متوازياً.
|



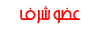

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


