( 6 )
والقمر يحكي لهم عن ألوان الذرة وعن حصاد الموسم ـ أو ما تعارفوا عليه بالخريف ـ إذا خَرِف الزرع مستوياً للحصاد , كانت آنية النساء مصفوفة تحت القُعُدْ مملوءة بالماء البارد , وقد غمسن فيها وُريقات الريحان تعبيراً عن أملهنّ في رحمة الله بالمتوفّين , ففي هذا استحضار لفضاء الجنّة كما يعتقدن , عند ذلك كانت الأمّ تُعاتب ابنها الشيخ : ( واَنَا اَمَّك قلت لكم اَنّ هذي حرب ما سبق وكُتبت في كتاب .. لو اَنّكم سمعتوني وقرّيتُم في بيوتكم ما كان جانا شِي .. وذا الحين ترى كيف اَحْنا مضيعين في هذي الدمن ؟! )
يسمعها الشيخ , وهي تٌعاتبه متحسّرة على وضعهم الشقي , دون حراك منه , إذ كان مشغولاً بليل " الهبّاش " , وهو في ساعتهم تلك يُواصل نداءه على رفاقه من فرسان القبيلة الأوائل , القاضين من قبل هذا , يستنجد بهم باكياً لنصرته ويستنكر الزمن الذي صار فيه ضريراً , ويتمنّى لو أنّه يُفرّق بين الّلونين الأبيض والأسود , وقد زاد امتعاضاً عندما علم أنّ الغزاة يُحاربون على جمال , وذرف دمعه المهيب عند هروب قومه به , فكان يصرخ فيهم : ( ليتني عادني اَفرّق بين اَمَبيض واَمسوَد والله لاَمزّقهم باَسناني ) , كان صوته يجوب عروق الجبال متصعّداً سفوحها حتى يخدش حلكة السماء , مثل جرح يتمدّد ويتلوّى فتيلا حارقاً في دماء الرجال جميعهم , وينزل في النساء رعباً , كان يصل الأمّ نداؤه لأصحابه الراحلين , يتناهى إليها مضرماً كجمرة الموت المباغت , فيكويها بمناجله الحادّة ودونما أثر يتركه فيها , إلاّ أنّ الأمّ التزمت رباطة الجأش , ليلزم البقيّة صمتاً فائضاً على حاجتهم , إلى أن قالت لابنها : ( يا عيسى كن رجل واسمع كلام اَمّك .. لا تطاوع شياطينك .. وقِرَ بروحك وخلّنا نرجع .. ترى ما لنا اَلاّ بيوتنا .. والله لو اَنا اَبصر أنّي ما أهجّ معاكم من عُصيْرَةْ .. لكن صرت تتحكّم بي لأنّي عميا .. من متى تخالف كلامي يا عيسى ؟! ) .
أنهت لمحة من حسرتها بحشرجة كادت تُبكيه , فقد شعرت بعجزها لأنّها عمياء , وإلاّ لبقيت في قريتهم " عُصيْرَةْ " , حيث شعرت لحظتها أنّها تنقاد لأمره كرعيّته , وهي التي كانت تأمر وتنهي طوال حياتها .
لقد كسرته بشكل لا يُظهره أمام الموجودين , فمدّ يده لرأسها وداعبها باسمها مجرّداً , يقول : ( يا صَادِقِيّةْ زمان اَنتِ أمّي .. لكن اليوم اَنا اَمّك واَبوك وولدك ) ثم استطرد متعمّدا ممازحتها كما اعتاد كلّما شعر بمنغّص يتخلّلها , ومحاولاً جلو روحها من الكدر : ( اِيضاً وشيخك يا صَادِقِيّة .. بس لا يكو نسيت هِرْجنا ذاك .. كاَنّك كبرت قليل ! ) , وهمهم بكلمات من خلا ضحكة مغتصبة , بعد أن ألمح إلى سرّ بينهما يُدبّران تحقيقه في الخفاء , وكأنّه بها تقدّمت في العمر فنسيت ذلك الأمر .
ردّت متسائلة بتعجب , كمن يرفض تعديل مسار حديثه : ( عادك متذكّر واَنت شاحنك الشيطان لهذي المقاتلة؟!).
صمت قليلاً حتّى عاد لجرح " الهبّاش " وصراخه في الليل فوجّه حديثه لأمّه متسائلاً : ( عسى يصلك صراخ علي هبّاش ؟ ) .
أجابته متهكّمة : ( الهبّش يرى شرّه وهو أعمى .. وأنت هبل وترى قوّتك .. فلا شرّ يردّ نظر ولا هبل يمسك قوّة ) , فضحك الشيخ هُنيهة قبل أن يُردف على كلامها , وكأنّه يُهدّئها , قائلاً : ( بكرة يلتقون مشايخنا بمشايخ هذي الدمنة.. شَا نِتشاور بيننا... ) .
صمتت كي لا تُضني نفسها بأمر لقائهم بمشايخ تلك المنطقة التي تستضيفهم , لأنها لا تعرف توجّه ابنها , وتعرف قدرتها فيما بعد على ثني كلّ قرار , إذا ما رأت أنّ إليه يُعدّ وبالاً عليهم جميعاً .
في المساء التالي كان الرجال جميعهم قد قرّروا أمراً لم تتوقّعه الأمّ كثيراً , فعندما أجمعوا علناً على التريّث في الرجوع إلى وادي " َالحُسَيْني " , وقد تتحسّن الأمور فيعودون لبيوتهم في الشقّ الأسفل المقابل لمقامهم ذاك , ومع هذا حلّت في بطن الشيخ غصّة كبيرة , وأمّه تشعر بذلك , وتعرف أنّه لن يرضى إلاّ أن يُلحق الكمد بمن تسبّبت في هذه " اَلهَرْبَةْ "لشمله الكبير, وهذا ما يردّده للجميع دائماً .




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس



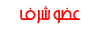





 ite...10939&Rname=27
ite...10939&Rname=27