المجتمع الإسلامي هو مجتمعُ المحبة، فأمَّةُ الإسلام أمة متحابة متوادة متراحمة متعاونة على البرِّ والتقوى؛ يقول - تعالى -: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح : 29]، كانت كذلك على مرِّ العصور، وما تزالُ في كثيرٍ من قطاعاتِها كذلك، ولله الحمدُ والمنَّة.
ولكنَّ البعد عن القيمِ الإسلامية، والإقبال على الدُّنيا أثَّر شيئًا من التأثيرِ على عددٍ من الناس، فحرموا من السَّعادةِ التي كان يحياها آباؤهم، وعليهم أن يعودوا إلى رياضِ المحبة والتوادِّ والتراحم، فذلك يحقِّقُ لهم الحياةَ السعيدة الكريمة في الدُّنيا، والفوزَ بمرضاةِ الله.
ليس هناك حياةٌ أحلى من الحياةِ التي يسعد بها المرءُ بحبه للآخرين وحبِّ الآخرين له، يعيشُ وصدره خالٍ من الضغائن والكراهية والحقد والحسد، بل يكون صدرُه مملوءًا بالحبِّ والودِّ والرحمة للآخرين.
إنَّ الحاجةَ إلى التذكيرِ بأهمية المحبة في المجتمعِ حاجةٌ كبيرة، لا سيَّما ونحن نُواجَه بحربٍ فكرية واجتماعية وعسكرية.
إنَّ كلَّ مسلم أخٌ لكلِّ مسلم؛ قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات : 10].
وهذه الأخوةُ التي تتبعها المحبةُ درجاتٌ من القريب، والجار، والصديق، والزميل، والخادم، والأستاذ، والتلميذ، كلهم إخوة يجبُ على المسلم أن يحبَّهم في الله، قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((سبعةٌ يظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله...، ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه..))؛ رواه البخاري برقم (660)، ومسلم (1031).
وقال في الأرِقَّاء: ويدخلُ في مفهومِهم الخدم، قال صلواتُ الله عليه: ((هم إخوانُكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يدِه فليطعمْه مما يأكلُ، وليلبسْه مما يلبس ولا يكلفه من العملِ ما يغلبه، فإنْ كلَّفه ما يغلبه فليعنْه عليه))؛ رواه البخاري برقم (6050)، ومسلم (1661)، وأبوداود (5157)، والترمذي (1945).
أجل، إنَّ الرحمةَ والمحبة بين المسلمين هي الصفة التي تميز المجتمعَ الإسلامي الحق؛ قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة : 54].
إنَّ الرحمةَ التي تكون بين المسلمين رحمةٌ تكاد تصلُ إلى درجةِ الذل كما جاء في برِّ الوالدين، وذلك في قوله - تعالى-: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء : 24]؛ أي: كن رحيمًا بهما رحمةً تصلُ إلى درجةِ الذُّل.
والمسلمون أمةٌ واحدة تقوم بين أفرادِها المحبةُ والأخوة والألفة والولاء؛ قال - تعالى -: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال : 63]، إنهم متحابون متراحمون، بعضُهم أولياء بعض؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : 71].
إنَّ هذه الصفاتِ هي مقوماتُ أمة الإسلام؛ وهي: (الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله)، ومن توافرت فيهم هذه الصفاتُ سيرحمهم الله، ما أعظمها من مكافأة!
هذا وقد ربط رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الإيمانَ بالتحاب، وجعل دخولَ الجنَّةِ محصورًا بالإيمان؛ فقال: ((لا تدخلون الجنَّةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا)).
ثم دلَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الوسيلةِ التي توصل إلى التحاب؛ فقال: ((أولاَ أدلُّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السَّلامَ بينكم))؛ رواه مسلم برقم (54). فإفشاءُ السلام وسيلةٌ من وسائلِ إيجاد التحاب بين أفراد الأمة.
وهناك وسائلُ أخرى تحقِّق الهدفَ نفسَه، نذكر بعضَها فيما يأتي:
• فمن هذه الوسائل: الهدية، فقد جاء في الحديثِ الحسن قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تهادوا تحابُّوا))[1].
• وجاء في الحديثِ المتَّفقِ عليه قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا نساءَ المسلمات، لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِن شاة))[2].
ينادي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - النساءَ المسلمات، ويدعوهنَّ إلى إهداءِ جاراتهنَّ، وينهاهنَّ عن احتقارِ الهدية اليسيرة الذي يقودُ إلى الامتناعِ عن الهديةِ، يقول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فرسن شاة))؛ والفِرسِنُ: بكسر الفاء والسين للبعيرِ كالحافرِ للدابة، وكالقدمِ للإنسان.
• والنساء يرغبن أن تكونَ الهديةُ قيمةً تنفع من تُقدَّم إليه، ويفتخر مقدمُها، وهذا شيء طيب إن تيسر، ولكنَّه لا يتيسر عند كلِّ الناس، وإن تيسر حينًا فلا يتيسَّرُ في كلِّ حين، ولو التزم النَّاسُ ألا يهدوا إلا القيمَ الجيد لقلَّ التهادي، وأصبح نادرًا، فيفوت بذلك المقصدُ الاجتماعي من الهدية، ولهذا خصَّ النبي - صلَّى الله عله وسلَّم - النساءَ المسلمات بندائه يدعوهنَّ إلى تقديمِ ما عندهنَّ من الطعامِ ولو كان قليلاً؛ لأنَّ القليلَ خيرٌ من العدم، ولأنَّ في تقديمِ القليل عند تعذرِ الكثير الفوائد الآتية:
• في ذلك تحقيقٌ لمعنى التحاب وترسيخ له في المجتمع، والنَّاس يقولون في أمثالِهم: "من تذكرني وأرسلَ لي عظمة كنتُ عنده عظيمًا".
• وفي ذلك تعويدٌ للمرءِ على البذلِ والعطاء، فمن اعتاد على تقديمِ ما عنده ولو كان قليلاً أعطى الكثيرَ عندما يوسِّعُ الله عليه.
هذا، واحتقارُ القليل من المهدي والمهدَى إليه أمرٌ قبيح، دلَّ على ذلك الحديثُ الذي أخرجه الطبراني من حديثِ أمِّ حكيمٍ الخزاعية قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، تكره ردَّ الظِّلْف؟ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما أقبحه! لو أُهدي إلي كُراعٌ لقبلت))[3].
والظِّلفُ للبقرةِ والشاة كالظفرِ من الإنسان، وجمعه أظلاف، مثل حِمْل وأحمال، والكُراع من الدَّوابِّ ما دون الكعب، ومن الإنسانِ ما دون الركبة.
فقرَّر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ ردَّ الهدية لقلتها أمرٌ قبيح.
وأخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لو دُعيت إلى ذراعٍ أو كُراع لأجبت، ولو أُهدي إليَّ ذراعٌ أو كُراع لقبلت))[4].
وأخرج مسلمٌ عن أبي ذر - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا أبا ذر، إذا طبختَ مرقةً فأكثر ماءها وتعاهدْ جيرانَك))[5].




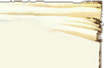
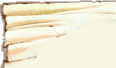









 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس








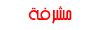









 - وزوجه.
- وزوجه. -
-