الورع..
كل مسلم يحب أن يكون من جلساء الله يوم القيامة لما لذلك من مقام عظيم، ولكن ليس من السهل أن نصل إلى هذه المكانة السامقة.. وليس من اليسير أن نرتقي هذه القمة، فالصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أضاء لنا المشعل ورفعه عاليا للناظرين فقال: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد.. والورع الذي يطهر القلب من الأدران، ويصفي النفس من الزبد.. الورع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "كن ورعا تكن أعبد الناس". وقالت عائشة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة.. الورع.
من هنا رأت "الدعوة" إجراء التحقيق التالي حول ماهية الورع وكيف كان حال الصحابة مع هذه العبادة وكيف نصل لدرجة الورع؟ وما الشروط المطلوبة في ذلك؟ وهل الورع فطري أم مكتسب؟ وكيف ندرب أبناءنا على الورع؟ وما اسباب تخلي الناس عن هذه العبادة في هذا الزمان؟
ثيرين..
بداية تحدث لـ"الدعوة" الشيخ: راشد سليمان الطيار (مفسر رؤيا) عن الورع قائلا: الورع والتقوى متلازمان ثم بيّن فضيلته كيف نصل لدرجة الورع؟
نصل لدرجة الورع إذا تجردنا من الدنيا وزينتها وزخرفها وتأسينا برسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم واتخذناهم قدوة في كل شيء..
أما الشروط في ذلك ألا نجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا.... نجتنب المحظورات والتحرج من الشبهات.
الكف عن الإباحات
الورع عرّفه السلف الصالح بأنه: الكف عن المحارم والتحرج منها وقيل إنه التحرج من الشبهات وقيل الوقوف على حد العلم من غير تأويل، وقيل الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات، وقيل الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين، وقيل الورع ترك المحظورات، وقيل الورع الكف عن الإباحات، وقيل الورع خلاصة أقوال المتقين وفضلها.
وفي الحديث الورع الذي يدع الصغيرة مخافة أن يقع في الكبيرة.
أما من ناحية هل الورع فطري أم مكتسب فنقول إنه مكتسب... ندرب أبناءنا على الورع ننشئهم على القرآن والسنّة... نكون نحن الوالدين لهم قدوة حسنة في المظهر والمبطن، نعاملهم ونفقههم بالحلال والحرام...
ومن أسباب غياب هذه العبادة في هذا الزمان حب الدنيا والتعلق بها.. ضعف الوازع الديني.. تعدد الفتن وكثرتها.. انتشار المحرمات والمجاهرة بها...
الاقتداء والتأسي
وكان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه العبادة أنهم اقتدوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أعمالهم فكانوا خير خلف لخير سلف.. كانوا يتنافسون بينهم بالورع والزهد والتقوى لاسيما نحن الآن نتنافس على الدنيا وحطامها عياذاً بالله..
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ثم هو (أي الورع) على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام.. والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع...
الورع مذموم ومحمود: فالورع المذموم مثل ورع الموسوسين وورع المتنطعين، وورع الموسوسين كمن يمتنع عن أكل الصيد خشية أن يكون كان لانسان ثم افلت منه وعمن يترك شراء ما يحتاج اليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامه تدل على الثاني وعمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل اباحته قويا وتناوله ممتنعاً او مستبعداً..
ورع المتنطعين
أما ورع المتنطعين مثل: إساءة الظن بالناس دائما مما يؤدي الى تجنب معاملتهم ولو كان حسن الظن هو الأصل لتمت المعاملة فالتنطع ان ترى الوساوس ونحوها من الشبهات...
قال النووي رحمه الله في (الاذكار) وفي (رياض الصالحين) وقال رحمه الله في (شرح مسلم) المتنطعون: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أموالهم وأفعالهم...
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه: هذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: هلك المتنطعون.
صيانة النفس
كما تحدث لـ"الدعوة" أ.د. سليمان بن قاسم العيد رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود قائلا:
عرّف أهل العلم الورع بتعريفات متفاوتة، فقال بعضهم: الورع هو ملازمة الأدب وصيانة النفس. وقيل: الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وقيل هو ملازمة الأعمال الجميلة. وقيل: الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وأصله قوله "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" والمعاني كلها متقاربة ومحصلتها صيانة النفس من الآثام.
خير مثال
لا شك أن صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خير مثال لهذه الأمة بعد إمامها (عليه الصلاة والسلام) وذلك لأنهم تعلموا الورع على حقيقته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الأمثلة على ذلك روى ابن سعد عن الأحنف بن قيس قال: كنا جلوساً بباب عمر فمرت جارية فقالوا سرية أمير المؤمنين فقال ما هي لأمير المؤمنين بسرية، ولا تحل له إنها من مال الله فقلنا فماذا يحل له من مال الله تعالى قال إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف وما أحج به واعتمر وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين.
وقال عكرمة بن خالد وغيره إن حفصة وعبد الله وغيرهما كلموا عمر فقالوا لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق قال أكلكم على هذا الرأي؟
قالوا: نعم.
قال: قد علمت نصحكم ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل.
وقال ابن مليكة كلم عتبة بن فرقد عمر في طعامه فقال ويحك آكل طيباتي في حياتي الدنيا وأستمتع بها؟
اللجوء إلى الله
إن الوصول إلى الورع أمر غاية في الصعوبة، ولا يمكن لمن كان على دراية بذلك إن يدعي الوصول إليه، وربما يدعيه أناس وهم من أبعد الناس عنه كجهلة المتصوفة ونحوهم، ولكن السعي إلى الورع الحقيقي أمر مطلوب، وإنما يطلب بصيانة النفس عن الآثام وتزكيتها بصالح الأعمال، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك.
لا شك أن الورع أمر مكتسب يصل إليه الإنسان بعمله، ففي الحديث القدسي: "من عَادَى لي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وما تَقَرَّبَ إلي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلي مِمَّا افْتَرَضْتُ عليه وما يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلي بِالنَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ" رواه البخاري، فدل الحديث أن الإنسان يتدرج بالعمل الصالح حتى يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، والذي يصل على محبة الله وصل إلى درجة الورع.
ورع الأبناء
إن غرس محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة أمره في نفوس الأبناء، وكذلك غرس الخوف منه وتعظيم نهية من أهم الأمور في تدريب الأبناء على الورع، إضافة إلى تبصيرهم بالأحكام الشرعية للتصرفات وما يترتب عليها من الجزاء من الأمور المهمة في ذلك.
الغياب لا يمكن الجزم به، ولكن نقول ما أسباب ضعفه؟ والأسباب كثيرة، فمنها قلة العلم الشرعي، وقلة القدوات من الورعين، إضافة زيادة التعلق بالدنيا، والآثار السيئة لوسائل الإعلام وغير ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى.
حجر محجور
وعلى ذلك الصعيد تحدث فضيلة الشيخ الدكتور: محمد الدويش حيث قال: الورع مصطلح من منا لم يسمع عنه؟ ومن منا لم يطرق سمعه؟ إن من يقرأ في سير السلف أو يستمع إلى وصاياهم أو يدرس سيرهم لا بد أن تتكرر هذه الكلمة على سمعه كثيراً، ويرى وهو يقرأ أنه يتحدث عن قضية تاريخية أصبح بيننا وبينها حجر محجور، وحين نقرأ سير السلف وأخبارهم في الورع والزهد والرقائق فإننا قد نحكم على تلك الروايات بالضعف والبطلان، وتارة نتهم من روي عنهم بالمبالغة والتشدد، وأخرى نتهم بالغلط والخطأ، وقد يكون شيء من ذلك صحيحاً، لكننا نادراً ما نتهم أنفسنا وأنها لم تَرْقُ إلى إدراك هذه المعاني، وأن قلوبنا لم تَصْفُ لترى أن ما عليه أولئك هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن ما عليه أولئك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف السابقين.
أقوال وشذرات
ولقد قدمت رِجْلاً وأخرت أخرى وأنا أريد الحديث حول هذا الموضوع، حتى أني وأنا أعد له وأقرأ عزمت ألا أتحدث عن هذا الموضوع، ليس تقليلاً من شأنه وأهميته، لكن شعور بأنه ينبغي ألاَّ يتحدث عن الورع إلاَّ أهل الورع، وينبغي ألاَّ يتحدث عن الصدق إلا الصادقون الخائفون المخبتون، والمتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لكن عزائي أن أقول لكم: اسمعوا مقالي وإياكم وحالي، فالقضية أقوال وشذرات من سير سلف الأمة نسعى إلى ربطها بواقعنا، ونقولها لإخواننا ونحن جميعاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الورعين المتقين الصالحين، وإن لم ترق أنفسنا إلى منازلهم فلنتشبه بهم؛ فإن من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه بالكرام فلاح.
الورع معشر الإخوة الكرام مصطلح نبوي شرعي؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ فقال? - فيما رواه البيهقي - في وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه: "كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً، وأَقِلّ الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب"
مصطلح شرعي
روى البزار والحاكم والطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه، ورواه الحاكم أيضاً من حديث سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فضل العلم أحب إليَّ من فضل العبادة وخير دينكم الورع"
ففي هذه النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أطلق صلى الله عليه وسلم فيها هذا اللفظ وهذا المصطلح، فهو إذن مصطلح شرعي نبوي، وإن كان ليس من شروط هذه المصطلحات أن ترد بنصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام المصطلح لا يعارض النصوص الشرعية فلا مشاحة في الاصطلاح.
أما الأدلة له على معنى الورع دون لفظه فهي أدلة كثيرة في كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث العظيم الجامع الذي جعله جمعٌ من أهل العلم أحد الدعائم التي يقوم عليها الإسلام، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الحلال بيّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه" والحديث مشهور في كتب السنة بروايات عدة، ويحفظه الصغير والكبير، وهو قاعدة في التورع مما يشتبه منه، مع أن معنى الورع -كما سيأتي- يأخذ مدى أكبر من هذا المدى ودائرة أوسع من هذه الدائرة، والتورع عن المشتبهات والبعد عنها ليس إلا باباً من أبواب الورع.
اطمئنان النفوس
ومن الأدلة في هذا المعنى حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وحين جاء وابصة بن معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: "جئت تسأل عن البر"، فقال: نعم، قال له صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك؛ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد والدارمي، وله شاهد عند الإمام أحمد من حديث ثعلبة، وهذا الحديث فيه إيماء وإشارة إلى تلك الحساسية المرهفة التي يملكها عباد الله الصالحون؛ فصارت نفوسهم تطمئن إلى البر وترتاح إليه، وصارت نفوسهم تأنف من المعصية وإن أفتاها الناس وأفتوها، ولا شك أن هذا الحديث مع ما فيه من الدلالة على الأمر بالتورع مما حاك في الصدر وإتيان ما اطمأنت إليه النفس، فهو إشارة إلى حال الصالحين وحال قلوبهم التي ترى بنور الله سبحانه وتعالى؛ فتطمئن هذه القلوب للبر والهدى والتقى والصلاح، وتشعر باشمئزاز ونفور وتردد من الإثم وأسبابه، ولو أفتاها الناس، وهذا المقياس في مسألة البر والإثم ليس إلا لعباد الله الصادقين، بل لعله أن يكون أمارة نختبر بها قلوبنا؛ فإن كانت تطمئن للبر والصلاح والتقوى وتشمئز من المعصية والسيئة وتنفر منها فهي قلوب صالحة بإذن الله، وإن كانت دون ذلك فهي بحاجة إلى تزكية وإصلاح.
وهو ليس خطاباً للمعرضين الذين علا الران على قلوبهم، فأصبحت نفوسهم مأسورة بهواها وشهواتها، فقلبه ونفسه إنما تطمئن لمعصية الله سبحانه وتعالى وإيذاء عباده المؤمنين المتقين، بل كم من الناس انقلبت الموازين لديه فأصبحت السيئة حسنة والحسنة سيئة.
التوجه إلى الله
إذن فهذا المقياس إنما هو لأولئك الصالحين الذين توجهت قلوبهم لله سبحانه وتعالى فأصبح القلب لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه إلا لله، وقبلته إلى الله عزّ وجلّ لا يفارقها؛ فكما أنه يستقبل القبلة في صلاته ويقف بين يدي الله عزّ وجلّ كل يوم خمس مرات فقلبه إنما قبلته لله لا يمكن أبداً أن يستقر في قلبه محبة غير الله أو التوجه له، أو أن يكون فيه إرادة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، لهذا ارتقت هذه النفوس إلى هذا القدر فصارت تطمئن للبر وتشمئز من الإثم؛ فمنحها الله عز وجل هذا النور وهذا الفرقان {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ }. وفي آية أخرى {وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ}.
كما أوضحت الاستاذة لمياء الجلاهمة - شبكة الحصن - تعريفا للورع وذكرت نماذج عن الورع قائلة:
بالاصطلاح الشرعي: يعرف الورع بأنه ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط، والورع اجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الورع: "عمّا قد تُخَاف عاقبته وهو ما يعلَم تحريمه وما يُشَك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله - فهذا قيدٌ مهم في الأشياء المشكوك فيها -، وكذلك الاحتيال بفعل ما يشك في وجوبه ولكن على هذا الوجه"
وعرف ابن القيم رحمه الله بقوله: "ترك مايُخشى ضرره في الآخرة"
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع في كلمة واحدة فقال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فهذا يعم الترك لما لا يعنيه من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع.
وروى الترمذي مرفوعاً: "يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبد الناس"
ولا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس، وقال بعضهم: "كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في الحرام"
مخافة المهالك
والإنسان المسلم عليه أن يتورع في الجوانب التي قد يؤدي الخوض فيها للمهالك سواء في النظر.. أو في السمع.. أو في الشم.. أو في اللسان.. أو في البطن.. أو في الفرج.. أو في اليد.. أو في الرجل.. السعي.. وهكذا..
والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الورع فقال: "الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس" رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"
نماذج الورع
ومن نماذج الورع حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصين فيمن قبلنا تورّعا عن شيء اكتشفاه في الأرض فاشترى رجل من رجل عقاراً فوجد فيه جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إني اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض بما فيها، فكل منهما تورع عن أخذ الذهب، فتحاكما إلى رجل عاقل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا" رواه البخاري ومسلم.
وكذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد سمع صوت زمارة راعٍ والإنسان غير مكلّف بما يسمع ولكن بما يستمع إليه فلا يجوز تقصّد السماع والتلذذ به، فمشى في الطريق بسرعة وابن عمر كان يضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع فيقول نعم، فيمضي على حاله واضعاً إصبعيه في أذنيه حتى قلت لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق. رواه الإمام أحمد وقال أحمد شاكر إسناده صحيح.
أفضل الورعين
وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلغ من ورعه في تلك القصة العظيمة التي رواها البخاري وهو أفضل الورعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يُخرِج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاءَ كل شيء في بطنه. رواه البخاري.
وتحدثت الاستاذة لمياء عن فوائد الورع قائلة:
وهذا الورع أيها الأخوة ينتج عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، فالخوف يثمر الورع والورع يثمر الزهد، فهذه المسألة مهمة جداً، فالورع له فوائد.. منها اتقاء عذاب الرحمن وتحقيق راحة البال للمؤمن وطمأنينة النفس وإنه يكفّ عن الحرام. ويبعده عن إشغال الوقت فيما لا يفيد، ويجلب محبة الله لأن الله يحب المتورّعين، ويفيد في استجابة الدعاء، لأن الإنسان إذا طهّر مطعمه ومشربه وتورّع يرفع يديه فيجاب له الدعاء، وأنه من مرضاة الرحمن وزيادة الحسنات، وحيث يتفاوت الناس في الدرجات في الجنة بتفاوتهم في الورع.
نقل القلب من الدنيا
والمسلم إذا نقل قلبه من الدنيا فأسكنه في الآخرة وأقبل على القرآن الكريم انفتحت له الأبواب وكان فيمن يستطيع تحمّل هذا الورع، وهناك حلال محضٌ بيّن وحرام محضٌ ومسائل مشتبهة بينهما، فلبس القطن والكتان والصوف والزواج بعقد صحيح وأخذ المال من الميراث أو هبة من إنسان ماله حلال أو شراء شيء ببيع صحيح، أمور الحلال المحض واضحة، وأمور الحرام واضحة كالميتة والدم والخنزير والخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال وأخذ الأموال المغصوبة والمسروقة والغش والرشوة.
والعلماء أنفسهم قد تشتبه عليهم أشياء فلا يفتون فيها أو يتوقفون عنها، ومن أمثلة الأشياء المشتبهة ما لا يُعلَم له أصل ملكٍ كما يجده الإنسان في بيته فلا يدري أهو له أم لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها"، ولكن من جهة التحريم والحل، فالأصل في المال الموجود في بيتك أنه لك، فجانب الحل أقوى، لكن إذا أردت الورع وتصدقت بهذا المال أحسن..
لا ضيق في الورع
فالخلاصة أن الورع منه دقائق لا تليق بأي أحد، بل ينكر على من تورع فيها إذا كان من أولئك الفسقة أو المتساهلين، وعلى أية حال فإن الورع هو من العبادات العظيمة وملاك الدين الورع، والفقيه الورع الزاهد المقيم على سنّة النبي صلى الله عليه وسلم له أجره العظيم يوم الدين، والإنسان ينبغي أن يضع نفسه في الموضع الصحيح في مسألة الورع كما قال الأوزاعي: "كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يُقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسُّم" وهذا الورع يُتَعَلَّم، كما قال الضحّاك بن عثمان رحمه الله: "أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام"، والإنسان إذا تورّع لن يعدم الحلال ولا يظن أنه سيضيق على نفسه ضيقاً لا مخرج منه فإنه يلتمس الورع الشرعي مثلما تقدم.
|



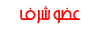

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس