هذا هو سوء الظن الذي يظنه المشركون والمنافقون *أ.د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان*
من منجم المصائب تأتي الأوقات الذهبية للأفراد والأمم، وفي حال المحن تجتمع القوى الفكرية حتى إنك لتظن المرء في حال من الشتات لما أصابه، فإذا به ينجز أعمالاً لا يقوم بها في حال غير هذه الحال. وانظر إلى الموت مثلاً فهو مصيبة من المصائب التي تعترض البشر وهو يضفي على المشاعر قوة ينظم فيها الشعر، وأصدق ما قالته العرب شعر الرثاء، فكم من محنة منحت لصاحبها من صفاء الذهن فجادت خواطره بأقوى الأفكار، وكم لله من نعمة على عبده لا يحصيها أحد، وكم من محنة في طياتها منحة، فعطاؤه - سبحانه وتعالى - نعمة، وحرمانه نعمة، وفضله جزيل، فهو أهل لأن يشكر في كل حال ويحمد في كل أمر في البأساء والضراء، في المنع والعطاء. وهذه المسألة من أعظم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون لا سيما في مثل هذه الأوقات التي تمر بأمة الإسلام، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال، وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل، وكذلك يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}، وقوله تعالى: {وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ }، وقوله: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ }، وقوله: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }، ونحو هذه من الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون، ويكون لهم النصر والظفر. وقال في سياق حديثه عن قوله تعالى: {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ }، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وقد فسّر بظنهم أن ما أصابهم - في غزوة أحد - لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه ففسّر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }. ثم ساق رحمه الله صوراً من ظن السوء فقال: من ظن أن الله لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوّي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملاً كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. إلى أن قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، فأكثر الخلق، بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء.. وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الزناد، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتباً على القدر وملامة له واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. والسعيد من طهَّر نفسه من ظن السوء بربه. وإن التاريخ مليء بالعبر وأولى الناس بالاستفادة منه هم المسلمون، فسنّة الله ماضية في الأفراد والأمم، وفي قصص القرآن والسُّنَّة وتاريخ الإسلام من الدروس والعِبر التي ينبغي أن يُستفاد منها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
|



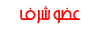

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس