قواعد شرعية في التعامل مع المخالفين بقلم: الدكتور سليمان بن عبدالله الماجد *
للتعامل مع المخالفين قواعد شرعية هامة ينبغي التنبه لها، فهناك أولا قواعد عمل القلب وأولها الخشية فقد كان من أعظم صفات العلماء الخشية، والعمل المخلَص، قال جل شأنه: { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}، وقال الله تعالى:{ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }.
وزوال الخشية أو نقصها من أعظم أسباب العدوان على المخالفين وبخسهم حقوقهم؛ حيث يحل محلها الهوى.
فليست أزمة قبول الحق والإذعان له أزمة علمية، أو معضلة في البحث والتحقيق، ولكن الأزمة الكبرى هي في التجرد من الهوى، والمؤثرات المتعلقة به. وعلاقة الشيخ بالتلميذ تدفع حتى بعضاً من المهتمين بالشأن الإسلامي إلى العمى عن رؤية الحق، ومن ثم العدوان على المخالفين.
ومما يؤكد وقوع الهوى أن بعض المسائل ضعف فيها الخلاف حتى قال صار قول الجماهير بل أئمة المذاهب الأربعة وعلمائها بخلاف هذا القول، ولكن حين صار السائد في نفس المكان هو قول القلة صارت المسألة توصف بأنها محل اجتهاد من أهل العلم، والأخذ بخلاف قول الجماهير له ما يسوغه. وتظهر آثار الهوى في عدم العناية بتأصيل المسائل التي قد تخالف سائداً، وكراهة بحثها، خشية من الوصول إلى نتائج لها تبعات. ومنها: أنك تراه إذا حط أحد على مبغض له لم يدافع عنه بطلب محاسنه؛ بل تظهر منه علامة الإعجاب والرضا. وإن حط أحد على محبوب بدا غضبه، وثارت ثائرته. ومنها حياؤه من عرض طروحات صحيحة يقول أو يعمل بها فريق، أو تيار آخر.
وقاعدة ثانية هي أن يكون مقصود المخالفة براءة الذمة بالبيان للأمة، إذ ينطوي قلب المؤمن على نية حسنة وسريرة صافية؛ فهو لا يريد من مخالفته لأحد إلا تعظيم الحق والبحث عن الحقيقة، ولا غرض له فيما سوى ذلك؛ كتقديس النفس أو الهوية أو الانتصار لهما، ومتى علم الله ذلك منه حصل له من القبول ومحبة الخلق وانتفاعهم به ما يرفع الله به قدره، ويخلد به ذِكْره.
وقد تشوهت هذه المعاني السامية عند بعض الناس؛ فحل محل الإخلاص: الرياء والتصنع، ومحل الحرص على الهداية: محبة النفس والدوران حول الذات وتعظيم الهوية الترابية من بلد أو عرق أو حزب أو عادة ومألوف.
وأن يحرص على الانتفاع من المخالف: فمن أعظم أسباب تأبي الحق على القلوب الكبر، وإشعار المرء نفسه أو الآخرين بأنه إنما بُعث إليهم هادياً لا يقبل مع ذلك توجيها أو تصحيحاً من أحد، وأن على الناس الاستماع إلى قوله وتوجيهاته ونصائحه. وبعض المسائل وإن كانت قطعية ظاهرة والشك فيها قد يكون كفراً إلا أن إظهار التنَزل الجدلي طريق صحيح لإزالة التوتر؛ فالله عز سبحانه وتعالى قد قال: { وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ }، ويقول تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ} ؛ فما الذي يدعو إلى التفكر مع كون القضية قطعية إلا توطين نفس المخالف على قبول الحق.
وأن يحرص على انتفاع المخالف لا ظهور القول، أو معقد الهوية: فيكون الباعث على المخالفة، أو مجادلة المخالف هو انتفاعه بما تراه من الحق؛ لا أن يكون القصد إرغامَه وإظهارَ خطئه عند الناس.
وحين كره السلف المناظرات فلعلهم إنما رأوا سبب ذلك قلة الانتفاع منها؛ لأن أكثرها إنما يراد منه إظهار الغلبة أو إذلال المخالف ومراغمته، ونتائج هذه المناظرات إنما تزيد المخالف عنادا، وتزيد أتباعه صدوداً.
وهناك قواعد العلم واليقين: فما وقع عدوان على مخالف إلا كان أكثر أسبابه جهل المعتدي فيما يتكلم فيه، أو جهله بكيفية التعامل مع المخالف في مثل هذا الخلاف. وحتى نعرف صحة هذا التقرير النظري فإن المتأمل في حال الأمة يرى أن أكثر نزاع المختلفين، الذي يؤدي إلى هذا العدوان هو في الجهلة والمقلدين لا في أهل العلم والمحققين، وما قد يقع من بعض أهل العلم فهو على وجه الندرة، أو الزلة.
فمن أراد أن يعرف أثر العلم في كل شيء، ومنه التعامل مع المخالف؛ فلينظر إلى أثر الجهل: إنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو الجمع بين المفترقات والتفريق بين المتماثلات، وإعطاء الشيء حكماً مبنياً على الوهم والشك، أو العصبية وإظهار الغلبة.
وأن يحقق المسائل: فالاكتفاء في مثل هذه القضايا بالثقافة العامة والمطالعات السريعة، والبناء على ذلك في نتائج نظرها إنما هو نوع من اعتبار الجهل والظن.
فلا تبرأ ذمة العالم إلا بإمعان النظر فيها، وتحقيق القول في مآخذها وقواعدها. والمسائل العلمية المتعلقة بالحكم على أي شيء، ومنه الحكم على المخالف تمر بمراحل أولها تخريج المناط؛ وهو استخراج ما يحتمل أن يكون علة للحكم ومقصدا له، وما يتبعه من تنقيح المناط، وما ينتجه ذلك من حكم المجتهد في المسألة بكونها كفراً أو فسقاً أو بدعة؛ كقوله بعد الاجتهاد: إن الحكم بغير ما أنزل الله على وجه التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة. وتحقيق المناط، وهو إنزال الحكم على الواقعة الجديدة؛ كقوله بأن قانون تشريع إباحة الربا في الحالة المعين هو هذا الكفر. والتحقق والتثبت من أن الذي نتعامل معه قد قال أو فعل ما يوجب أو يجيز عقوبته؛ فكثير من الناس يبني على مجرد الإشاعة، أو على ما يقال في وسائل الإعلام، وعلى النقل الذي يتغير عند الشخص الواحد أكثر من مرة؛ فكيف عند طول السلسلة. والتحقق من قيام الحجة التي يكفر منكرها، ووجود الشروط وانتفاء الموانع. ووصف الفاعل بآثار فعل المخالفة؛ بـأن يقال عن شخصه: إنه كافر أو فاسق أو مبتدع. وإظهار هذه الأحكام أو إخفاؤها بالنظر إلى المصالح والمفاسد، واختلاف الأزمنة والأمكنة، واختلاف الأشخاص الحاكمين والمحكوم عليهم.
وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى جمع علمي، ثم تأمل وموازنة، ثم إصدار الحكم.
فهل استقصى الناس في مخالفاتـهم للآخرين هذه المراحل، أو أن واقع كثيرين هو ارتجال إصدار الأحكام، والتسرع في تطبيقها عليهم؟ وأن ينبذ التقليد: فليس من العدل ولا من العلم أن يقلد المرء غيره في الحكم على الآخرين، وما يترتب عليه من التعامل معهم بهجر أو تنفير أو عقوبة، أو الحكم على أحد بكفر أو فسوق أو بدعة؛ فما كان قطعياً فلا تقليد فيه لظهوره، وما كان محل اجتهاد أهل العلم، أو مشكوكاً فيه لم يجز لأحد أن يخرج من المقطوع به، وهو حرمة عرض المسلم، ولزوم وفائه جميع حقوقه بأمر مشكوك فيه لا يعرف وجهه ولا دليله، والعالم المستدل فيما يختار من أقوال، وفي مواقفه: يجد ما يُخرجه من العهدة، ويبرئ به الذمة، ولكن ما الذي يُخرج المقلد؟
وأن يتثبت ويتبين: فكثيرا ما يقع الظلم والعدوان على المخالف بسبب العجلة وأخذ الكلام من مصادر غير معتبرة؛ إما في ورعها، وإما في ضبطها وحسن فهمها، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }.
|



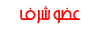

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس