أسطورة اسمها (( قصيدة البيت الواحد )) !!
دراسة نقدية
د : جابر قميحة
(2)
البيت الواحد .. والوحدة العضوية : وفي سبيل ذلك يلوي السيد التليسي النصوص بعيدا عن مقاصدها فيما يستشهد به من كلام النقاد ، حتى يخلص من ذلك إلى أن كبار النقاد والمؤرخين نصوا على استقلالية البيت الواحد ، ووفائه بالغرض ، فالتليسي يرى أن ابن خلدون "وقف في مقدمته إلى جانب البيت المستقل" . وينقل عن ابن خلدون للتدليل على ذلك النص التالي : (( والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام في مقصوده ، ويصلح أن ينفرد دون سواه ، فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب ، فيبرزه مستقلا بنفسه ، ثم يأتي ببيت آخر كذلك ، ثم ببيت آخر ، ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده ، ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع بعضها بحسب اختلاف الفنون التي في القصيدة )) .
والنص السابق لا يعني - عند ابن خلدون - استقلالية البيت بنفسه استقلالا باتا حاسما ، وإنما يعني أنه يحمل "فكرية جزئية مستقلة" تمنحه ما يمكن أن نسميه "التمام أو الاستقلال الجزئي" . وهذا ما جعل بعض النقاد العرب يكرهون التضمين بأن يكون تمام المعنى بالبيت الثاني ، كأن يكون الشرط في الأول وجوابه في البيت الذي يليه ، كما ترى في قول توبة الحميري :
ولو أن ليلى الأخـيلية سلمت علي ودوني تـــربة وصفائح
لسلمتُ تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح
ومما يدل على أن ابن خلدون يقصد باستقلال البيت "الاستقلالية الجزئية" ، هو ما ختم به نصه السابق (( .. ثم يأتي ببيت آخر كذلك ، ثم ببيت آخر ، ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده ، ثم يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع بعضها بحسب اختلاف الفنون التي في القصيدة )) .
وهذا ما يتفق تماما مع نص آخر لابن خلدون استشهد به التليسي ، وفيه يقول ابن خلدون : (( ثم يستأنف "الشاعر القديم" كلاما آخر كذلك ، ويستطرد للخروج من فن إلى فن ، ومن مقصود إلى مقصود بأن يوطئ المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناسب المقصود الثاني ، ويبعد الكلام عن التنافر ، كما يستطرد من النسيب إلى المدح ، ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو الخيل أو الطيف ، ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره ، ومن التفجع والعزاء في الرثاء إلى التأبين ، وأمثال ذلك .. )) .
وخلاصة ما نستخلصه من نصوص ابن خلدون :
1- أن البيت يستقل بفكرته بحيث يمكن إنشاده منفردا معزولا عن غيره .
2- أن هذه "الاستقلالية" لا تقطعه قطعا حاسما عما يليه ، بل يأتي بعده الثاني والثالث إلى أن يستوفى "الفن" داخل القصيدة الواحدة كالنسيب ووصف الناقة ومدح الممدوح .. إلخ .
3- وهذه الأبيات - بما لكل منها من استقلالية جزئية - يجب أن يتحقق بينها "التناسب" والبعد عن التنافر ، فتحقق "الوحدة الفنية" في نطاق الفن الواحد "النسيب أو المدح أو وصف الناقة .. إلخ" داخل القصيدة الأم .
4- ثم هناك "تناسب" آخر لابد منه ، وهو خلق الصلة بين هذه الفنون أو "الوحدات" داخل القصيدة الأم ، بالخروج من النسيب إلى المدح مثلا ، ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره ، فلا يخرج الشاعر مثلا من المدح إلى التأبين ، أو من النسي إلى الرثاء .
وقد راعى الشاعر القديم أن تكون "النقلة" من فن إلى فن - داخل القصيدة الأم - هادئة لطيفة ، وهو ما أطلق عليه النقاد والبلاغيون "حسن التخلص" .
وما استخلصناه ينتهي بنا إلى أن القصيدة القديمة قد تحقق فيها - بشيء من التسامح - الوحدة العضوية بمفهومها العام ، لا بمفهومها الحاد الصارم الذي يصعب - إن لم يستحل - تحققه حتى في شعرنا المعاصر ، إذا استثنينا الملحمة والقصة الشعرية . وقد فصلنا القول في ذلك من قبل .
وينقل لنا التليسي عن ابن طباطبا ما هو أصرح مما ذهب إليه ابن خلدون في مسألة الوحدة العضوية . يقول ابن بطباطبا " ينبغي للشاعر أن يتأمل شعره ، وتنسيق أبياته ، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه ، ولا يجعل بين ما ابتدأ وضعه وتمامه فصلا من حشو ليس من جنس ما فيه . ولكن يبقى أوضح التصورات كلها للوحدة العضوية هو ما كتبه الحاتمي "مثل القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التراكيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه ، وتعفى معالمه .
ويرى التليسي فيما ذكره ابن طباطبا ، وهو رأي نقله عن إحسان عباس أن "الوحدة العضوية عند ابن طباطبا تعني وحدة البناء وحسب" .
وهو حكم لا معنى له ، فوحدة البناء تعني الوحدة العضوية . وكلام ابن طباطبا يوحي بأن الوحدة التي يعنيها يشمل الجانب التعبيري والجانب الفكري والجانب الجمالي . ويرى التليسي أيضا بأن في رأي الحاتمي ضعفا أتى من ناحية " ما ورد في نهاية كلام الحاتمي من إيماءات توحي بقبول فكرة تعدد الأغراض في القصيدة ، وحسن التخلص في انتظام نسيبها بمديحها " .
فإذا نظرنا إلى ما أشار إليه التليسي ، وضعف على أساسه رأي الحاتمي وجدناه بالنص " وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها ، وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها عن جزء " . فتضعيف التليسي لرأي الحاتمي لا يقوم على أساس ، وترفضه نصوص الحاتمي التي استشهد بها التليسي ، فرأيه في الوحدة العضوية فيه من الحسم والصرامة ما يتفق مع ما يذهب إليه النقد الحديث . فهو كلام إذن لا يحتمل التأويل والتخريج الذي طرحه التيلسي .
مفهوم القصيدة : وهو يصر على أن البيت كان وما زال هو "الأصل" وهو "الأساس" ، وأن كبار الشعراء في الشرق والغرب ما اشتهروا إلا بالأبيات المفردة .. نعم المفردة التي قد يهبط أحدها إلى كلمتين فقط .. يعني قصيدة ذات تاريخ وعنوان !! . وجرّه هذا الإصرار إلى ضرورة مراجعة المعنى الشائع للقصيدة ، ويتحقق ذلك - في نظره - بالعودة بهذا المصطلح إلى جذوره اللغوية وهي لا تعدو الإنشاد أو بلوغ القصد للشاعر في بيت أو بيتين ، فتلك هي القصيدة التي تحيط بعالمه وتستنفد مشاعره ، فلا مزيد .
واستخلاصا من كلامه السابق يمكن أن نعرف القصيدة - في نظره - بأنها "ذلك الإبداع المنظوم الذي يحيط بعالم المبدع ، ويستنفد مشاعره ، ويستغرق تجربته في بيت واحد أو بيتين على الأكثر " .
ونحن نوافقه تماما على المضمون - بصرف النظر عن المصطلح - ونوافقه - من باب التسامح الكبير - على هذا التحديد الكمي في حالة واحدة ، وهي ألا تجود قريحة الشاعر في "الموقف" إلا بالبيت أو البيتين ولا مزيد . وفي تاريخنا الأدبي أمثلة متعددة من هذا اللون ، ومنه ما أجاب به شاعر مسلم عمن سأله عن أبيه ونسبه :
أبي الإسلام لا أبي لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم
ومثال البيتين - ولا مزيد - ما يروى من أن أبا تمام حينما وصل في مدح الخليفة العباسي إلى قوله :
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس
اعترض عليه بعض حاسديه بقوله : ( ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بصعاليك العرب ) . فأجاب على البديهة :
لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس
فالله قد ضرب الأقل لنـوره مثلا مــن المشكاة والنبراس
فالبيتان - كما هو واضح - قد تلبسا بالموقف ، وعبرا عنه تعبيرا استغرق شعور أبي تمام وفكره دون تزيد أو إسراف . ومثل ذلك أكثر من أن تحصى في تراثنا العربي القديم ، ويمكن أن نطلق على البيت من هذا اللون "البيت المتوهج" أو اللامع أو الجامع أو "بيت الموقف" ؛ لأنه يمثل موقفا نفسيا معينا ، وانفعالا صادقا لا يخلو من عمق ، ولكنه سريع عابر ، على أية حال .
أما التجربة الشعرية فهي عملية معقدة ، ذات امتدادات متكاملة ومتفاعلة ، واستغراقها - بالمفهوم الفني الناضج - يحتاج إلى رقعة لغوية أرحب مدى من البيت والبيتين ، وهو ما يسمى بالقصيدة . والذين قدروا حدها الأدنى بثلاثة أبيات أو سبعة لم يسرفوا ولم يغلوا في التقدير . وكان تحديدهم هذا أقرب إلى واقعنا الأدبي الفعلي من تحديد التليسي فيما سماه "بقصيدة البيت الواحد" التي جعل حدها الأعلى بيتين .. نعم بيتين ، ولا مزيد .
ولكن لماذا الوقوف عند بيتين ؟ يخطر لي في هذه اللحظة الأبيات الآتية لمتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك :
لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك
فقال أتبكي كــل قبـر رأيته لقبر ثوى بين اللـوى فالدكادك
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قــبر مـالك
إنها أبيات ثلاثة - لا قبلها ولا بعدها - تعد دون خلاف من أرقى نماذج الشعر العربي على الإطلاق في صدق الانفعال وعمق الشعور وروعة التصوير والتعبير ، وبراعة هذا الحوار الثنائي على قصره . فهل تصدق "نظرية" التليسي على هذه الأبيات ؟ أعني هل يمكن أن يصدق عليها ما سماه "بقصيدة البيت الواحد" .
إن جاء الجواب بالإيجاب فهذا يعني أن السيد التليسي قد نسف "نظريته" بنفسه ؛ لأنه وقف بنظريته - من ناحية الحكم - عند البيتين ولا مزيد . ومن ناحية أخرى سيفتح "تسامحه" هذا الباب على مصراعيه لما يمكن أن يسمى "بقصيدة المقطوعة" التي تتكون من أربعة أبيات أو خمسة .
وإن كان الجواب بـ"لا" لقلنا إن الشعر ليس علما رياضيا إحصائيا حتى نستعبده بهذا التحديد الرقمي الصارم . ولقلنا كذلك إن أبيات متمم السابقة تفوق جودة وفنا وصدقا كل النماذج التي غصت بها أحشاء كتاب التليسي ، وطالب الأستاذ النقاش أن نكتبها على جدران المطارات والحافلات والمحطات ومترو الأنفاق ! .
__________________
المصدر : الأدب الحديث بين الموضوعية وجناية التطرف .
|



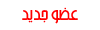

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس