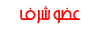فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }الحجرات6
وقال ايضا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }الحجرات12
إذا كان الوحي الذي يكشف المنافقين والكاذبين قد انقطع
فإن الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية للتبين والتثبت لم تنقطع
وما أحوج المؤمنين عامة والدعاة خاصة لأن يتدبروها ويتخلقوا بها.
مزالق عدم التثبت
من أول مزالق عدم التثبت سوء الظن
ولذلك يقول الغزالي – رحمه الله -:
ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل.
ثم ينحدر الظان إلى مزلق آخر، وهو إشاعة ظنه ذاك
وقد نقل الشوكاني عن مقاتل بن حيان قوله:
فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم.
وحكى القرطبي عن أكثر العلماء:
أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز.
وقال الغزالي: اعلم أن سوء الظن حرام، مثل سوء القول..
فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال
وهو بعين مشاهدة أو بينة عادلة.
ويقول ابن قدامة رحمه الله:
فليس لك أن تظن بالمسلم شرًا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل
فإن أخبرك بذلك عدل، فمال قلبك إلى تصديقه، كنت معذورًا...
ولكن أشار إلى قيد مهم فقال:
بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟.
ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل:
بلغني أنك وقعت فيَّ وقلت كذا وكذا.
فقال الرجل: ما فعلت.
فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق.
فقال الرجل: لا يكون النمام صادقًا.
فقال سليمان: صدقت.. اذهب بسلام.
والفطن من يميز بين خبر الفاسق وخبر العدل
ومن يفرق بين خبر عدل عن ندٍ له
أو عمن يحمل له حقدًا، وبين شهادة العدل المبرأة من حظ النفس
ومن يميز بين خبر العدل وظن العدل، والظن لا يغني شيئًا
ومن يفرق بين خبرٍ دافعه التقوى
وخبر غرضه الفضيحة أو التشهير.
والذي لم يتخلق بخلق (التثبت) تجده مبتلى بالحكم
على المقاصد والنوايا والقلوب، وذلك مخالف لأصول التثبت.
يقول الشافعي – ووافقه البخاري -:
الحكم بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين
بما لفظوا به، وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك.
ومن أخطر المزالق أن يحسن الأمير الظن برجل من الناس
ليس أهلاً للثقة، ثم يكون أسيرًا لأخباره، أُذنًا لأقواله، يصغي إليه ويصدقه.
يقول ابن حجر:
المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول
من لا يوثق به، إذا كان هو حسن الظن به
فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك.
ومن أصول التثبت ألا يؤخذ أحد بالقرائن
طالما هو ينكر ولا يقر.
وشواهد ذلك في السنة كثيرة،
ومنها ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله
عنهما أن رسول اللهقال:
" لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة، لرجمت فلانة، فقد ظهر فيها
الريبة، في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".
ومع ذلك لم يرجمها رسول اللهلأنها لم تقر، ولم يقذفها بلفظ الزنا.
استمع للطرفين
ولا شك أن من أهم أصول التثبت فيما يُنقل من أخبار:
السماع من الطرفين
فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبيأرسل عليًّا رضي الله
عنه إلى اليمن قاضيًا، فأوصاه:
"...فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع
من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء".
يقول علي رضي الله عنه: "ما شككت في قضاء بعد"
فكان الصواب حليفة بالتثبت
وكم زلّت أقدام، ووقعت فتن بسبب عدم التثبت!!
يقول الشوكاني: الخطأ ممن لم يتبين الأمر، ولم يتثبت فيه
هو الغالب، وهو جهالة.
وكم تجد من الناس من يسارع للشهادة على أمر لم يفقهه
في حق امرئ لا يعرفه!!
ولذلك أفتى الحسن البصري تحريًا للتثبت:
لا تشهد على وصية حتى تُقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف.
لا تتسرع في الحكم
وليس من خلق المتثبت التسرع والعجلة
وإن رسول اللهحين أرسل خالدًا رضي الله عنه للتحقق
من عداوة بني المصطلق
"أمره أن يتثبت ولا يعجل".
ولما أرسله إلى بني جذيمة للتحقق من إسلامهم فتعجل في القتل.
قال: "اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد" [رواه البخاري].
بل إن مما ذكر القاضي شهاب الدين الشافعي في كتابه
"آداب القضاء": وعليه – إن لم يتضح له الحق
– تأخير الحكم إلى أن يتضح..
قال الشوكاني في تفسيره لقول الله تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ): ومن التثبت:
الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع
والخبر الوارد، حتى يتضح ويظهر.
شاور العلماء والصالحين
وإن سؤال العلماء ومشورتهم يسدد المتثبت
وقد نقل ابن حجر عن الشعبي – بسند جيد – قوله:
"من سرّه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء، فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير".
ولا تخافوا من المشورة فإنها تقربكم إلى الحق.
هل هذا من التثبت؟
وكثيرًا ما يُتهم شخص بتهمة فينفيها، أو يبين عذره فيها
ثم يستمر الحديث عنه والتحذير منه
فهل هذا من التثبت؟!
إن حاطب بن أبي بلتعة حين صدر منه إفشاء سر النبي
طلب عمر أن تقطع عنقه، غير أن رسول اللهاستمع إليه
حتى إذا انتهى قال:
"صدق، لا تقولوا له إلا خيرًا" [رواه البخاري].
وكل مسلم ظاهره الصلاح صادق ولا نقول له إلا خيرًا..
وإلا فإن الاتهام بغير تثبت سبب في كثير من المظالم،
ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد أمرائه
– عدي بن أرطأة أمير البصرة – في قتيل وُجد عند بيت
ولم يُعرف قاتله: "إن وجد أصحابه بينة،
|







 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس