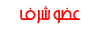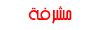المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستريح البال

وهل بقي احد في تورا بورا هههههههه كأنك سعيد أن اكتسحتهم أمريكا
حيث دولة الخلافه المزعومه
يا مستريح ! دولة الخلافة كانت حلماً اجتهد فيه ف أزعج وأرعب
من أزاله وشوه حتى معالمه وبضدها تتميز الأشياء.
اتعلم ياصديقي
ان خشية اسلافهم من الافتتان بالشقراوات قد حدثت في غزوة تبوك
من المعني هنا ؟! هل المتخلفين المؤثرين للحياة كيف كانت أم المؤثرين الفناءطلباً للعزة ؟!
ونزل في ذلك قران يتلى
بل هو التابكي بعينه ولن ينصفك احد
لقد بدل الشيخ جلده ؟
طيب ومالمشكلة في تبديل المواقف والافكار
فقط ليقدم لك طلبا بان تجيزه
ماعلم بااغر الصحوة هنا والا فسيأتيك ولو حبوا
هنا نظن انهم انقرضوا منذ زمن
قال فيهم العوده ان الله يحب في المسلم صلاته وعبادته
فلم تستعجل الفناء
بالفعل ثقافة الموت متأصله في نفوس هؤلاء المغرر بهم
لا يوجد أحمق يلهث خلف قتل نفسه بلا هدف
وإلا كانوا شنقوها في منازلهم .
وعلى الأهداف تقاس النوايا.
مثل :
الفلسطيني حين يفجر نفسه لقتل يهود هل نقول عنه ماقاله العدو أنها هستيريا الموت
و
الشعور بالاحباط في هذه الدنيا
ايضا الحور العين دعم مكارثي خطير بل هو كوارثي
بماذا تسخر هنا ؟!
علام قام الإسلام ؟! وكيف قد يستعيد العزة ؟!
كأنك تقول يجب حذف مفردة الجهاد من المصحف ؟!
وما الجهاد؟!
من يسخر اليوم ممن يحلم برفع عزة الدين ولو بحياته
فلن يجد غداً من يستنصرهم للابقاء على حياته .
انني اعجب ان احدا من الدهماء ينتقد رمزا
هذه اشكالية النسق
اتدري لقد اشتقت فعلا للخطاب التعبوي زمان والله.
وضع الأمة خير خطاب تعبوي مستريح لكن المشكلة
لا يوجد مخاطَب رجل الكل يخاف الموت ويؤثر الفلة الفارهة والسيارة ويردد(ان الله يحب في المسلم صلاته وعبادته
فلم تستعجل الفناء )صلوا في الحانة في الكنيسة في المعبد ونعال الكافر على رؤوسكم لا يهم .
لم لم يقنعوا ثوار سوريا ب التعبد في بيوتهم وعدم استعجال الموت
أي تناقض تحياه هذه الزمرة



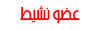

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس