بعد أن استبقا الباب
سهام العريشي ـ جازان
بجانب عتبة الصمت وقفتْ. تختلس السمر مع أعمدةٍ صلب على امتدادها حلم يقظةٍ متدلي العينين، هزيل المقاومة، مسلوباً حتى من كفن. تعبره كل يوم من أعلى كبريائه إلى أخمص مقدمٍ فيه. تتأكد من خلو الشارع من الصدف ثم تجرجر أذيال خيبتها نحوه وقبل أن يدس عقرب الزمن سمه في الوقت الضائع تخرج من جيب ملاءتها السوداء عطراً بنكهة الغياب تغري به حلماً أوشك على الإغماء.
يوم كباقي الأيام المستندة على أوراق التقويم، اصطفت مع العشرات في انتظاره ليوصلها نحو مقر العمل، هناك حيث ابتزت منها الملفات لقمة عيش إزاء سنواتٍ من العمر.
لم يكن وهماً إحساسها بأنه سيأتي كخيار أخير لآخر خير تنتظره، فقد كانت تحفظ نظراته الحارقة عن ظهر قلب، وتوجس في نفسها من التفاتته خيفة، تشربت من أمانيها الظامئة ذات انتظار ثم أيقنت أن الأربعين عاماً لن تفوّت عليها القطار فحسب، بل سيدفعها اليأس لتصطدم بعربات تشبه الحب ولا تكونه!.
"أريد طفلاً يحمل أمسي"...، قالت إثر توعكها من الخوف القادم ثم همست لتلك التي تجاورها مقعد الحافلة: "لا ضير في الخمسين عاماً وإن كان به مس من شيب"!.
أرجفت مذعورة حين أحنى مرآة الحافلة لتعكس صورته صوب نافذتها مباشرةً، ليخترق -عن سابق خبرة وتودد- حلمها المشرع على مصراعيه، المنبثق من ثقوب الرجاء، حلمها المشدود من أقصى ضفيرة الأربع سنوات إلى مفرق الرأس في الأربعين.
تمتمت بصوت زل صمته: في الأحلام، من العيب أن ننشر أمنياتنا الصغيرة على حبال الحرية خشية أن تفضحنا دون أن تلامسها شمس! في حين أن بإمكاننا طرحها عرضاً في فناء المنزل لتتنفس صبراً، تتلوى برداً، ثم تنتشلها من التراب كف لم تعرف غير الوحل قفازاً لها.
خلقت الأحلام البسيطة لتنفذ بسرعة وكأنها تمتن بحضورها إلينا!، إنها أفراح مغرضة، تدفن سم الهمّ في مسمى عسل، تشي بنظراتنا إلى الخلف وهي تلوي رقابنا إلى الأمام، تحرض التشرد الروحي وبتواطؤ منا على السكن فينا لئلا ندفع ثمن الحياة خارج حدود الدخل، قال لها وهو يمعن في دفع قلبها نحو جادة الخطأ: "معك يا زوجتي أشعر أنني أعود ثلاثين عاماً إلى الوراء، إلى سني الشباب وبدع المراهقة". أثنته عن التوغل في براءتها أكثر. بادرها متسائلاً: "ماذا عنك؟".
اشتمت رائحة الخيانة ثم همست لداخلها: "أعود معك مرهقة".
كالتضاريس التي تجحف في توزيع الفصول على منتظريها، تقاوم كل يوم على باب الرتابة كميةً لا بأس بها من كرات الثلج، تكنس من صدرها ما تبقى من نثار الشتات، وتودع في خزانة الترقب حقائب تدفئ فيها برداً وطمأنينة. ثم حين تنتهي من مهامها في تأنيث قلبه، تفر نحو الفراغ ليقلل من تكاثر الفوضى فيها. يأمرها بأخذ استراحة تحت قدميه الموحلة إمعاناً في تذكيرها بالخطيئة الأولى حين ساقتها الأيام قسراً نحوه. يرفسها، حيث المشاعر الحافية لا تأبه بتمريغ الآخرين في حبٍ من عدم. يطفئ ثورته في منفضة حلمها ويصرخ متباهياً!.
في غمرة انشغالها بفرحة لم تكتمل نسيت أن تدون في الذاكرة عنوان تنازلها الأول. أنّى لها إذن أن تعرف طريق العودة إلى الكبرياء؟! بكثير من التغابي نثبت أننا أذكياء أحياناً، إذ لا يوجد طريق عودة إلاّ في خرائط الوجل الوهمية!، لا يمكن للريح أن تولد نسمةً من جديد، ومحال أن تعود الكرامة بكراً. أماطت اللثام عما بقي من ماضيها ليأتيها صوت صديقة الطفولة على خطٍ آخر: "لقد عثر على ضحية جديدة ليتزوجها، أتصدقين؟ كان يقوم بتوصيلها معنا على ذات الحافلة!".
وضعتْ سماعة الهاتف وألف سؤالٍ يغزوها: "لماذا تصر العجلات على دهسنا حتى وإن كنا نحن فوقها؟"...، "كيف يمكن أن تتعثر أقدامنا بصدمة تسقط من أعلى؟".
أجهضت طفلها أمومةً لم تولد، وطالب بصيص الحياة في عينيها بلجوء ودي للفرار من ظلامه بالحسنى. سمعته قبل أن يصم أذنيها صراخ الدم المهدور: "موافق، لكن كم ستدفعين؟".
**
|





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
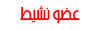

 - فَلاَ تَغِبْ عَنَّا مُطَوَّلاً.
- فَلاَ تَغِبْ عَنَّا مُطَوَّلاً.