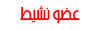الإعلام الإسلامي.. الواقع والمستقبل
مرت الصحوة الإسلامية - في العالم العربي على وجه الخصوص - بمراحل متعددة، وجربت الحركات الإسلامية أساليب متنوعة للتأثير في المجتمع.
كانت التربية الفردية صورة راسخة لدى مدارس دعوية متعددة، وكانت الخدمات الاجتماعية وسيلة لدى فئات إسلامية للوصول للمستهدف وإقناعه بالفكرة الإسلامية.
بالطبع اعتمدت بعض التيارات أسلوب القوة والعنف للتغيير أو - على الأقل - لحماية مجتمع الدعوة المستهدف.
في فترة متأخرة اكتسحت الاتجاهات الإسلامية مواطن التأثير الإسلامية (في الكثير من البلدان الإسلامية) وشاركت في مؤسسات المجتمع الفاعلة، وتأثيرها أصبح ملموساً لدى قطاعات عريضة من المجتمع.
ومع ذلك ما فتئت جماعات الدعوة الإسلامية تتعرض لهجوم ونقد من بعض الجهال ومن الكثير من أصحاب الاتجاه المغاير الذين يرون في الدعوة الإسلامية تهديداً لهم فكرياً واجتماعياً وحتى اقتصادياً.
كان الإعلام هو ميداناً لكثير من هذه المعارك، ولئن كان التيار الإسلامي - في كثير من الأحيان - مشاهداً أو مستهدفاً، فإن قلة من هذا التيار من وعت خطورة هذه الأدوات الجديدة وتأثيرها في معركة الصراع بين قوى الحق والفضيلة وتيارات التغريب والعلمنة.
إن وعي الصحوة الإسلامية بالإعلام وأهميته ودوره جاء متأخراًً، مما سبب فوات الكثير من المصالح والتعرض لكثير من التشويه والإقصاء.
كما أن إدراك جماعات الدعوة الإسلامية للإعلام لم يصاحبه دراسات نظرية تأصيلية ولا برامج تدريبية عملية، وغلب على الأمر اجتهادات فردية ورؤى شخصية.
ورغم حرص الكثير من قادة العمل الإسلامي على الاستفادة من الإعلام دعوياً إلا أنهم لم يستطيعوا توفير الكوادر البشرية والتمويل المادي لتحقيق تلك الرغبات والأماني.
وقبل الاستطراد ما هو الإعلام الإسلامي؟!
يمكن تقسيم الإعلام الإسلامي - بحسب المفهوم - إلى نوعين: ديني وغير ديني.
الأول يتمثل بالجانب الدعوي الشامل بدءا من القواعد الأساسية للإسلام مرورا بالأخلاق والقيم الإسلامية.
الإعلام الديني الإسلامي يمثل استغلال أدوات الاتصال والمعارف الإعلامية لإيصال الدعوة لكافة الناس مسلمهم وكافرهم، لتصحيح الواقع السيئ وهداية الضال.
وهو - بهذه الصيغة - شبيه بمنابر الجمعة والدروس الدينية والخطب التوعوية إلا أن الفارق هنا هو قناة التواصل الجماهيرية غير المباشرة والاستغلال الأمثل للتقنية للإقناع والتأثير في المخاطب.
النوع الثاني هو الإعلام الهادف والذي لا يستهدف التوعية الدينية لكنه ينضبط بأصول الإسلام وقواعده العامة، فلا يقدم ما يخالف ذلك (مما اتفق عليه)، وان كانت المادة ثقافية أو تعليمية أو حتى ترفيهية بحتة.
نعم قد تتضمن المادة الإعلامية رسائل هادفة جزئية أو كلية لكن ذلك ليس قاعدة دائما وأيضاً ليس شرطا لانطباق التسمية.
أما واقع الإعلام الإسلامي فتمثل في تحديان:
الأول خارجي والثاني داخلي من الصف الإسلامي.
أما الأول فتمثل في العقبات القانونية من صعوبات في الحصول على التراخيص أو المنع بالكلية في بعض البلدان أو غياب القوانين المنظمة لبعض الأنشطة الإعلامية وأخيراً الرقابة الصارمة على المادة الإعلامية (الصحف والمجلات) والإغلاق لمواقع الإنترنت ذات الرأي المخالف للسلطات المحلية.
وبالنسبة للشأن الذاتي فتمثل في غياب الخطط والإستراتيجية العامة للاستفادة من الإعلام كجزء من منظومة التغيير والإصلاح.
أما المشاريع الإعلامية فتميزت بالصبغة الفردية والرؤية الأحادية التي مثلت مصالح ذاتية أحياناً.
أيضا ارتبطت بعض المشاريع الإعلامية الإسلامية بمؤسسات خيرية فجعلتها مغلولة إلى العنق مرتبطة بسياسات هذه المؤسسة ورؤاها.
تاريخيا غلب مفهوم الإعلام الديني خصوصا في الصحافة مما أضعف من تأثيرها وقلل من انتشارها.
كما شاب الإعلام الإسلامي غياب التنسيق مع أهل الفكر والدعوة والعلماء والمثقفين ومثل - في كثير من الأحيان - القائمين عليه أو الجهات المرتبطة به.
في الجانب الإداري عانى الإعلام الإسلامي من التشرذم والتنافس وكانت غالب المؤسسات صغيرة ضعيفة لا تقوى على الصمود طويلا.
في نفس الوقت كانت الحرفية في التسويق منخفضة والنكسات متوالية.
أما في جانب الرؤية والخطاب الإعلامي فكان الأمر في الغالب اجتهادات فردية وأحادية في الرأي مع ضعف في تقبل الرأي المخالف، وشاب الكثير من الأعمال الإعلامية عدم استيعاب للتقنيات الحديثة في فنون الاتصال واقتصار الخطاب على فئة المتدينين وليس جماهير الناس.
أيضاً غلب الخطاب العاطفي والوعظي على العقلي التحليلي وغلب الخطاب المباشر على الرسائل الإيحائية.
كانت قلة الخبرة وندرة الطاقات البشرية فضلا عن التحديات المالية عقبة كؤود أمام الكثير من المشاريع الإعلامية الإسلامية مما تسبب في توقف البعض أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة.
ورغم التحديات الجسمية الداخلية والخارجية فإن الإعلام الإسلامي حقق نجاحات ملموسة، فهذا الشريط ضرب أطنابه (خصوصاً في دول الخليج ) وحاز الكتاب الإسلامي على الأرقام الأولى في التوزيع، كما صدرت العديد من المجلات الإسلامية الاجتماعية والدعوية واستطاعت أن تنافس في سوق شرسة مع انخفاض في المقروئية.
في الجانب المرئي صدرت المئات من أشرطة الفيديو سواء الحوارية أو الثقافية أو الوثائقية أو الأطفال واحتلت نصيباً لا بأس به من هذا السوق.
وتوج الأمر بظهور قنوات فضائية إسلامية وهي - رغم تباينها موضوعيا وفنيا - إلا أنها حققت حضوراً ملموساً وبدأ الناس يشاهدون مادة محترمة تربوية ودعوية ضمن خضم الإسفاف في الإعلام المرئي.
ولا ننس الإنترنت حيث الآلاف من المواقع الإسلامية التي مثلت حضورا مبكرا خلاف وسائل الإعلام الأخرى.
هذه النجاحات - بالطبع - محدودة ولا تقاس بالمطلوب ولا تمثل حد الكفاية الواجب وحتى عدديا لا تمثل منافسة حقيقية لكنها ولعلها أول القطرة والأمل بتركز التجربة وانتشار الفكرة.
إن الأمة وهي تحاول النهوض تحتاج مجموعة من المقومات والأدوات ولاشك أن الإعلام يمثل ركناً أساسياً في قضية الإصلاح في المجتمعات المسلمة، ووسيلة ضرورية في حرب العقائد والأفكار.
إن جزءاً من الضعف والهوان الذي نخر في الأمة المسلمة كان بسبب الإعلام وغياب الإعلام الإسلامي عن الساحة، مما ترك للإعلام الآخر الفرصة ليوغل في الفريسة ويتركها وقد قطعها إربا إربا.
هذا لا يعني الانعزال عن المجتمع أو التقوقع أو الإحجام عن الإعلام الآخر، بل من المفترض اختراقه وتسخيره - ما أمكن - لخدمة القضية الإسلامية، وان بصور جزئية، أو على الأقل تقليل مصادر الشر والفتنة التي تنطلق منه.
إن الإعلام الإسلامي وهو يحبو في خطواته الأولى من خلال مشاريع يسيرة لكنها جادة وعازمة لهو في أمس الحاجة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للواقع المعاصر كي يساهم بفعالية وبذكاء في التغيير والإصلاح.
هذا الأمر يستدعي وجود طاقات شابة مؤهلة ومدربة وذات حماس عال ورغبة جادة للاستفادة من الإعلام بكافة صوره وأساليبه ليكون أداة لانتشال الأمة من غفلتها ووسيلة لإعادة مجد الحضارة الإسلامية الضائع ولبنة لتكوين المجتمع المسلم الفاضل والمنشود.
|



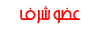

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس