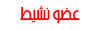في محاضرة علمية شاملة.. الدگتور فالح الصغير:وعيد شديد بحق من يقول على الله بغير علم
الأحكام المستقرة
قسَّم أهل العِلم الشريعة، إلى أصول وفروع، وأحياناً يقسمونها إلى قواعد وأمثلة على هذه القواعد، وأحياناً يعبِّر بقضايا ثابتة ومستقرة وقضايا متغيرة. إذن هي من حيث التقسيم هي قسم لا يتغير ولا يتبدل مطلقاً مع مرور الزمن، سواء اختلفت الأمكنة أو اتحدت، أو اختلفت الأحوال أو اتحدت. هذه القضايا الثابتة في دين الله عزَّ وجلّ يمكن أن تجمل في الأمور الآتية:
أولاً: أحكام العقيدة، فأحكام العقيدة وبخاصة أصول العقيدة، هذه الأحكام مستقرة لا يجوز الحيدة عنها مطلقاً، مثل قضية أن "أركان الإيمان ستة" كما في حديث جبريل عليه السلام، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... إلخ الحديث"،
كذلك من القضايا الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل بأحوال المكلفين، مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال في هذا الدين، منها المجمع عليها وهي: القرآن والسُّنّة والإجماع والقياس، ومنها ما يراه بعض أهل العلم ولا يراه البعض الآخر، فمصادر الاستدلال مستقرة ولا يجوز أن نخلط معها غيرها بأي حال من الأحوال.
من القضايا الثابتة ما طبقه أهل العلم من مصادر الاستدلال من قواعد مستقرة سواء كانت قواعد أصولية أو كانت قواعد فقهية أو قواعد عملية في أمور الحياة بعامة.
كذلك الأمر الرابع من الأشياء المستقرة، الأحكام الفقهية التي نصَّ على استقرارها مثل "ما كان معلوماً من الدين بالضرورة" وهنا يعبِّر عنه عن بعض الأحكام التي لا تقبل الجدل والخلاف، "كذلك القضايا المجمع عليها" فالمجمع عليها لا يجوز الخلاف فيها أو الحيد عنها أو عدم تطبيقها. كذلك "ما كان الخلاف فيه شاذاً" نص أهل العلم على أن الخلاف في هذه المسألة شاذ، والشذوذ يأتي من عدم معرفة العالم الذي قال بهذا القول، مثلاً بالدليل أو الذي لم يظهر له وجه الدلالة، لكن عامة أهل العلم على خلافه، فهذا يعبَّر عنه بأن الخلاف شاذ، وإذا كان الخلاف شاذاً فلا يُنظر إليه. كذلك ما كان الخلاف غير معتبر مما نص عليه من أهل العلم، فإذا كان الخلاف غير معتبر، كأن يكون المخالف غير مسلم مثلاً، أو يكون المخالف يؤيد بدعة ذهب إليها، فهذا يعبَّر عنه بأنه خلاف غير معتبر، فهذا لا ينظر إليه وإنما ما خالفه.
هذه الأحكام المستقرة التي عُبِّر عنها بهذه التعابير، هذه أحكام ثابتة في الدين لا يجوز تغييرها أو استبدالها بغيرها ونحو ذلك. وما مر الأمثلة عليه كثيرة مثل أركان الإيمان، أركان الإسلام، مثل الصلاة على وقتها، مثل الوقوف بعرفة، أحكام الميراث التي وردت في القرآن، الحدود التي نص عليها في القرآن، الأحكام في القضايا العامة مثل الأمر بالمعروف، حكمه، الدعوة إلى الله، مثل القضايا الأخلاقية العامة، مثل الفضائل بالنسبة للمستحسنة، الرذائل بالنسبة للمستقبحة، كذلك ما يتعلق بالكبائر التي نص عليها، السرقة، الزنا، القتل، وما إلى ذلك من هذه الأحكام، هذه وأمثالها لا يجوز الخلاف فيها بأي حال من الأحوال لاستقرارها استقراراً في الدليل واستقراراً في التطبيق على مدار الزمن.
طبعاً لا يجوز استبدالها في الأحوال العادية، لكن قد ترد أحوال استثنائية مثل الإكراه وهذه لها أحكامها المستثناة.
الأحكام غير المستقرة
أما القسم الثاني فهي أحكام مستقرة من حيث الدليل والنظر، لكن يختلف التطبيق وذلك راجع لعدة عوامل مثل:
الزمان والمكان وأحوال المكلفين، فهذه قد تتغير بالزمان، المكان، أحوال المكلفين، ولذلك أمثلة كثيرة، مثلاً، الصلاة من المعلوم أن من أركان الصلاة أن يصلي المسلم قائماً، والصلاة قائماً هي ركن من أركان الصلاة، وهل يجوز أن يصلي جالساً؟ لا يجوز إلا عندما يرد عارضاً من العوارض مثل المرض، فالمرض هنا غيَّر الحكم، إذن الحال هنا غيرت الحكم، ولكن أصل الحكم لا يتغير، فأصل الحكم لا يتغير وإنما الذي تغير هي حال المكلف في تطبيقه لهذا الحكم. مثال آخر، الجهاد، الجهاد مبدأ من المبادئ في هذا الدين حكمه العام لا يتغير، فرض كفاية لكن قد يتغير للأعلى سيكون فرض عين في حالات معينة ذكرها أهل العلم، وقد يكون أقل من فرض الكفاية وقد يكون أقل أكثر بحيث لا يجوز، كما في أحوال الفتن، فأحوال الفتن لا يجوز أن نرفع راية القتال، وهكذا ، فإن الحكم هنا تغير وبتطبيق المكلف نتيجة لزمان أو مكان أو حال من الأحوال.
الدعوة إلى الله جلَّ وعلا، حكمها ثابت ومستقر هي واجبة على العموم، وواجبة على الأعيان، أحياناً يرتفع الحكم إلى فرض عين، مثل الأب في بيته، حكم الدعوة هنا فرض عين لأنه مسؤول، قد تكون سنّة وقد تكون أقل إذا ترتب عليها منكر أكبر، فإذا ترتب منكر أكبر صار الأمر هنا لا يجوز بأي حال ما دامت هذه الحال موجودة، ما دام أنه يخلِّف منكراً أكبر من المراد رسالته، وهكذا.
هذه أمثلة سريعة للتغير، فالتغير المراد ليس تغيراً لذات الحكم، فالحكم مستقر وإنما الذي يتغير أحكام المكلفين وتطبيقات المكلفين بالنسبة للحكم، كذلك من الأشياء التي تحتاج إلى النظر وتسمى متغيرات، الأشياء المستجدة، ويسميها أهل العلم "النوازل"، فالنوازل تسمى في عرف اليوم "متغيرات" جديدة ومستجدات وهذه تحتاج إلى اجتهاد في تنزيل الأحكام، لا تحتاج إلى مسار معين واضح يعرفه كل أحد، بل يحتاج إلى من له الأهلية لأن يطبق عليها الحكم الشرعي، هذه أيضاً التي تسمى متغيرات أو مستجدات.
أمثلة لمتغيرات تاريخية
هل وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ نعم وقع، وهل وقع في عهد الخلفاء الراشدين؟ وقعت أحوال كثيرة اختلف فيها الاجتهاد من وقت إلى وقت، ومن خليفة إلى خليفة نتيجة للعوامل المحيطة بهذا الأمر، على سبيل المثال، بناء الكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن الكعبة على قواعد إبراهيم وإنما بناها على ما كانت عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن القوم حديثي عهد بالكفر، فربما لو بناها على غير ما يعلمون لربما سبَّب فتنة، وهي الكعبة وقبلة المسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها على الأصل وإنما جعلها على ما كان الناس متعارفين عليه.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين الذين كانوا في زمانه لكن عامة الناس لا يعلمون هؤلاء المنافقين، وقد اشتهر أمر عبدالله بن أبي بن سلول ومع ذلك لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدَّ الرِّدة لا يستتيبه في الكفر ولم يتعامل معه بشيء من ذلك مع علمه صلى الله عليه وسلم بحاله وإنما عامله معاملة المسلم لأنه كان مسلماً في الظاهر. في عهد الخلفاء الراشدين، جمع القرآن، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان متفرقاً، فلما تفرق الناس وقتل من قتل من القراء، اجتهد الخليفة الراشد أبوبكر رضي الله عنه بأن يجمع الناس على مصاحف معينة ولم يخالفه الصحابة رضوان الله عليهم بذلك وهذا أمر جديد، متغير جديد تطلب اجتهاداً من الوالي فعمل باجتهاد معين.
ومن المعلوم أن شارب الخمر حدُّه أربعون جلدة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاء زمن عمر اجتهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه رفع الحد إلى أن يكون ثمانين، هنا متغير، ما هو المتغير؟ نظراً إلى ظاهرة، هذه الظاهرة هي استشراء أو انتشار شرب الخمر فأراد أن يرفع الحد ليتعامل الناس مع هذا الأمر بشيء من الحزم، ومع ذلك وافقه جملة من الصحابة على هذا الحكم. هل نستطيع أن نضبط هذه المتغيرات في ضوابط؟ نعم بلا شك، بأن نرجع للقاعدة أن هذا الدين كامل وشامل وأتمه الله سبحانه وتعالى وأكمله، لكن ما هذه الضوابط التي نستطيع أن نضبط بها، سبق السؤال من أجل أن ندرك التسلسل الذي يراد هنا، لكن لا مانع أن نعطي قاعدة عامة، هذه القاعدة في هذا الأمر، هي من أعظم القواعد التي أشار إليها أهل العلم، وهي أن بناء هذه الشريعة على مصالح العباد، ولذلك يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد"، يقول الشاطبي رحمه الله: "والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل ودرء المفاسد عنهم" هذه القاعدة إذا ضبطت ضبطنا المسار، لكن لا شك أنها تحتاج في ضبطها ومن ثم ضبط المسار المرتبط بها إلى عامل.
أنواع المتغيرات
من خلال التقسيم السابق يتبين لنا أن هناك قضايا لا يجوز الخلاف عليها، ولا يجوز تغييرها بأي حال من الأحوال، وهناك مسائل سواء كانت هذه المسائل موجودة وجاء عامل من عوامل التغير، أو مسائل جدّت تحتاج إلى شيء من الضوابط. يمكن النظر لهذه المتغيرات من عدة جوانب أو زوايا.
الزاوية الأولى، النظر في التغير من حيث حكمه، وهل هو يحكم عليه بأنه إيجابي أم سلبي، هذا الجديد شيء إيجابي أو سلبي، فبحسب نوعية التغير يحكم عليه. أيضاً التغير من حيث المكان، قد يكون الحال في هذا المكان غير الحال في مكان آخر. وتعلمون أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، تغيرت الأحكام، قد يمنع الخليفة أمراً كان سائداً فيمنعه، وقد يرتب الخليفة حكماً غير الحكم الذي أصدره القاصي ، يزيد في التعزيرات مثلاً، نتيجة لمكان معين أو حال معين.
أيضاً الزاوية الثالثة، التغير من حيث تعاملنا معه، لو نظرنا إلى تعامل المجتهدين، أو تعامل عامة الناس فسنجد أن التعامل هنا منوع كما سنأتي عليه بعد قليل. أيضاً التغير من حيث المجالات، قد يكون التغير في مجال اجتماعي أو مجال علمي أو في مجال الأفكار أو المجال الاقتصادي والأموال وقد يكون فيما يخص الرجال أو النساء أو تغير محلي أو تغير إقليمي أو غير ذلك.
أمثلة معاصرة
على سبيل المثال، القنوات الفضائية، القناة من حيث هي قناة، هي وسيلة من الوسائل، لكن إذا أردنا أن نعطي لها حكماً من الأحكام الشرعية فسننظر إلى ما يكون فيها، لو قلنا إن هذه القناة الموجودة فيها إيجابي، تطلبت منا أحكاماً شرعية أخرى، هذه الأحكام تحتاج إلى إعادة نظر في بعض الأحكام التي قد نقول إنها ثابتة مثلاً، القنوات التي يقال إنها إسلامية، لا شك أن فيها قضايا تحتاج إلى إعادة نظر، مثلاً، التصوير، المستقر ما هو أنه محرم بلا شك ولا ريب، وما يكون تصويراً لا شك في حرمته ولن يختلف أهل العلم فيه إذن، الخلاف أين يكون؟ في هل هو تصوير أو غير تصوير، إذن التغير هو الآن في نوعية هذا الذي وجد في هذا المتغير. القنوات قد تصدر أعمالاً هي في حاجة إلى إعادة النظر، مثلاً التمثيل، التمثيل نازلة من النوازل في العصور المتأخرة، فعندما نقول هذا التمثيل بمجرد أن نطلق عليه إسلامياً من حكم التحريم إلى الحكم الشرعي هذا يحتاج إلى نظر المجتهد. مثلاً الرسوم الكاريكاتورية، هذه والتي لا تعطي شكل إنسان أو حيوان فيه حياة، تصور الإنسان بصورة كبيرة جداً أو تصور حيوان صغير بصورة كرتون، مثلاً هي تأخذ حكم التصوير؟ لا شك أنها تحتاج إلى نظر. نظر المجتهد في إعطائه الحكم. سنجد أن الناس مع المتغير الإيجابي، هذا الذي يعتبر إيجابياً، هنا ستختلف نظرات المجتهد لهذا المتغير. أيضاً مشاهدة المرأة للرجال، قضية مشاهدة المرأة للرجل، هي قضية فكرية معلومة مبحوثة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل وردت فيها نصوص من القرآن ومن السنّة، لا إشكال في ذلك. هذا المتغير الإيجابي تستطيع المرأة تنظر أم لا تستطيع؟ يعني نقول لها جائز أم نقول لها لا يجوز؟ وهكذا، فسنجد أننا نحتاج إلى نظر المجتهد هنا في هذا المتغير.
التعامل الإيجابي
ثم حدد الدكتور الصغير معالم المنهج السائد في الوسط الإسلامي في التعامل مع المتغيرات المعاصرة قائلاً : هناك أيضاً المنهج الثاني وهو المنهج الذي ينادي بالنظر إلى هذه المستجدات بنظر دقيق وأن يتعامل مع هذه المتغيرات بما يسمى التعامل الإيجابي بأن ينظر إليها ويطبق عليها الحكم المناسب لها سواء من حيث الدليل أو من حيث القاعدة الأصولية أو قاعدة شرعية أو قياس أو غير ذلك. وهؤلاء أقسام بالنسبة لواقعنا المعاش.
القسم الأول:
قسم غلب عليه النظر إلى هذه المتغيرات من واقع ما يسمى بالفقه المقاصدي أو فقه التيسير. وهذا الموضوع أرجو من الإخوة أن يركزوا معي لأن هذه المصطلحات إذا استخدمت في غير استخدامها قد يفهم الإنسان فهماً غير الفهم المراد. هذا قسم غلب عليه النظر إلى يسمى "الفقه المقاصدي" و"فقه التيسير" والمقصود من "الفقه المقاصدي" هو أن ينظر إلى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تستوعب هذا الأمر أم لا تستوعبه.
هذا المنهج نجده في الواقع كما ستأتي بعض الأمثلة المهمة، يمكن - وهذا الإمكان من عندي - يعني استخلاص بعض معالم هذا المنهج، ومن معالمه كما سبق (أن النظر إلى المقصد مقدم على النظر إلى النص)، ولو كان النص ظاهراً - أي من القرآن أو السنَّة - فهذا ينظر إلى مقصد الشريعة، ويحينئذٍ يتعارض عنده المقصد الشرعي مع الدليل الشرعي فماذا يقدم؟ يقدم المقصد الشرعي، وربما يكون الدليل قاطعاً في مثل هذه المسألة يأتي النظر العام عندما يقال له إن هذا خلاف في الدليل يأتي المعلم الآخر وهو أن ما كان فيه خلاف يسوغ الأخذ بأحدهما على الإطلاق. فالنظر في مسائل الخلاف عنده أنه ما دام أن هذه المسألة خلافية فيجوز أن آخذ بهذا القول أو بهذا القول، وهذا إطلاق واسع قد يحده الدليل.
ويميل أتباع هذا المنهج إلى النظر العقلي "عقل الفرد" على الدليل حتى ولو كان الدليل واضحاً. فيقول غير معقول أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، وطبعاً الأصول الحديثية والحكم على الحديث أمر مستقر قد يصطدم بهذا الكلام لكن يأتي للأمر الآخر وهو النظر في تفسيره من حيث نظره هو "يعني من حيث عقله هو" فيقول هذا في زمن غير زماننا، وهذا مثاله المثال المعروف، في مثلاً ولاية المرأة للولايات العامة، جاء فيها نص قاطع رواه الإمام البخاري وغيره رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أنكروا الحديث وسيأتينا معلم من المعالم، لم يسغ لهم إنكار الحديث وجدوا أنهم يصطدمون بقواعد إصطلاحية مستقرة،، ذهبوا إلى تفسير الحديث بأن هذا كان لسبب خاص، لكن لم يدركوا أيضاً أن هذا مضبوط بضوابط عند أهل العلم لا يوجد في الدليل ما يدل على أنه لسبب خاص. أتوا للنظر العقلي، قالوا المرأة الآن تولت في الغرب وفي الشرق ومع ذلك لم تقل لم يفلحوا، فلجأوا للنظر العقلي ففسروا الفلاح بأنه فلاح في وقت معين، في زمن معين، لكنهم لم يأخذوا معنى الفلاح العام والشامل في الدنيا وفي الآخرة وهكذا.
منهج غير منضبط
هذا المنهج لا شك أنه في النظرة الأولية، أنه منهج براق يسوِّغ لكثير من الناس، مثل بعض أنصاف المثقفين وما يطلق عليهم ببعض المفكرين وبعض طلبة العلم الذين لم يتمكنوا، فضلاً عن سائر الناس وبخاصة كما أشرت في كثرة المتغيرات التي قد تكون أحياناً بالشهر أو بالأسبوع وباليوم وبغير ذلك. هذا المنهج لو أخذناه منهجاً عملياً لتطبيقه في أمور الحياة كلها لوجدنا عندنا نحن المسلمين أن منهج الاستدلال يختل، أن مصادر التشريع تختل، أن قواعد الشريعة تختل، أن هذا المنهج يغلب عليه الاضطراب، لا نجد قواعد تضبط هذا المنهج، فأنا أنظر إلى التيسير نظرة وأنت تنظر إليه في نظر والثالث ينظر إليه على أنه ليس تيسيراً ومن ثم لا نجد ضوابط تضبط هذا المنهج، وأنت تقول إن هذا غير معقول وأنا أقول إنه معقول، وأنت تقول الدليل هذا لسبب ما من الأسباب عُمل به وانتهى وأنا أقول إن الدليل ثابت، فحينئذ سنجد أن مصادر الاستدلال مختلة، أن مناهج الاستدلال مختلفة، أن قوعد الشريعة غير منضبطة وأن الاضطراب يغلب على هذا المنهج.
القسم الثاني:
الذين ينظرون إلى التعامل مع المتغيرات بنظرة إيجابية، قسم غلب عليه التردد، العواصف قوية بلا شك، لكن أيضاً ما لديه من العلم قوي ومن هنا يغلب عليه التردد، وهذا الضبط الذي يسمى ضبط الواقع ونحوه يغلب على الإنسان أحياناً فتهتز عنده قاعدة من القواعد الشرعية أو يهتز نظره إلى الدليل ومن ثم يقع في هذا التردد وبذلك يغلِّب جانب السلامة، وهذا إذا كان على المستوى الفردي لا ضير فالسلامة مطلب من المطالب، أعظم من يقع في المحظور.
معالم المنهج الوسط
القسم الثالث:
وهو الذي يعتبر المنهج الوسط، الذي يتعامل مع الدليل الشرعي، كما جاء، يتعامل مع المصادر والأدلة ومصادر التشريع، يتعامل مع المقاصد الشرعية في وضعها ومكانها. هذا المنهج له معالم، من أهم معالمه أنه يعمق إيماننا بمصادر التشريع وهي القرآن والسنّة والإجماع والقياس فلما نعمق إيماننا بهذه المصادر، هذا أول حاجز من أن نضل في الشدة وكما عبَّرت عنه "بلا" لكل شيء في ضوء هذه المتغيرات، وهو أيضاً ضابط، لئلا نضل بعقولنا ونصل إلى ما لا نحمده.
كثر كلام المستشرقين في السنة أكثر من القرآن، فالقرآن لا يستطاع الدخول عليه، والله جلّ وعلا بيَّنه وحفظه كما هو، والسنة محفوظة بلا شك ولذلك نحتاج إلى تعميق الإيمان بها من حيث ثبوتها ومن حيث الاستنباط منها ومن حيث العمل بها، ومن حيث الدفاع عنها؛ فإذا تعاملنا معها في ضوء هذه المسارات استطعنا بإذن الله أن نضبط ضابطاً كبيراً يحجز كثير من الزلل والخلل.
المعلم الثالث: توضيح مقاصد الشريعة ومقام هذه المقاصد ومتى تصلح للاستدلال ومتى لا تصلح. الشريعة لها مقاصد، ومن هنا لما كثر الكلام في هذه المقاصد، أخرجها أهل العلم بعلم ومن أقطاب هذا العلم الإمام الشاطبي رحمه الله، فوضح هذه المقاصد وتحدث عنها في كتابه "موافقات" حديث طويل، ومن ثم توالت التأليفات، ووجد في كلام الإمام ابن القيم وفي التطبيقات التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير من إبراز هذه المقاصد، هل المقصد بذاته دليل أو ليس دليلاً ومتى يكون دليلاً ومتى لا يكون دليلاً؟ نحتاج إلى شيء من التوضيح بحيث تضبط هذه المقاصد، ولا شك ولا ريب أن المقصد الشرعي لا يخالف الدليل، وأن الدليل لا يخالف المقصد الشرعي، لكن لو وقع تعارض بينهما ولم نجد حلاً للتوفيق نأخذ بظاهر الدليل لأننا مُتعَبدون به.
التيسير وقاعدة الضروريات
المعلم الرابع، أن التيسير من أهم مقاصد الشريعة بلا شك ولا ريب، والله جلَّ وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وهذا المعنى جرى في القرآن وفي السنّة وفي تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم بما لو أخذنا وقتاً كبيراً للحديث عنه لما كفاه ساعة أو ساعتان، ولكن المقصود هنا أن نقرر التيسير مقصد من المقاصد الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ما خيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد وما غالب أحد التيسير إلا غلبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقاته يميل إلى التيسير، لكن لهذا التيسير أيضاًَ ضوابط، ليس التيسير هو تمييع الدين، ليس التيسير هو أن يترك الدين للهوى والمزاج ولمثل هذه العبارات أو المصطلحات التي نسمعها بين الفينة والأخرى. من أهم الضوابط بقاء التيسير على الدليل الشرعي ومن ثم فلا يجوز تحكيم الشهوات ولا الأهواء. الأمر لثاني أن لا يتعارض مع نص من الكتاب ومن السنَّة الصحيحة. الأمر الثالث عدم الخلط بين قاعدة التيسير وقاعدة إباحة الضرورات أو قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة جزء من التيسير وليس التيسير كله فهي جزء من التيسير في هذا الدين، إذا وصل الإنسان إلى حافة الضرورة كأن يموت وإلا يأكل الميتة، يأكل الميتة، أو يشرب الخمر، أو غص بلقمة ما ولم يجد أمامه إلا الخمر يدفع به الغصة وإلا يموت لا شك أن هنا، الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس التيسير هو هذه القاعدة، هذه جزء من القاعدة، قاعدة التيسير فلا نخلط بينهما ومن أخذ بالتيسير بإطلاق قاسه على هذه القاعدة.
العقل والنص
الأمر الرابع، إطلاق التيسير ليس للعقل وحده، بل لمجموعة العوامل التي أشير إليها وبناء على هذا، فليس من التيسير التفريق في الأحكام الشرعية وليس من التيسير العمل بمصادر الاستدلال في القرآن والسنَّة والتحكم هذا نقبل، وهذا غير معقول، وهكذا.. ليس من التيسير إعطاء العقل الحق المطلق، العقل لا شك كرَّمه الله سبحانه وتعالى، وكرَّم الإنسان بهذا العقل، لكن لا شك أن له حدوداً من أهمها ألا يكون العقل حاكماً على النص بل النص حاكماً على العقل. أيضاً ليس من التيسير اتباع الرخص، قال أهل العلم: "من تتبع الرخص فقد تزندق". والرخص أن نأخذ بالخلاف وننظر إلى الأيسر من هذا الخلاف ونأخذ به.
ما يجوز وما لا يجوز الخلاف فيه
أيضاً من المعالم المهمة في ضبط هذا المنهج للحق أن نعرف ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز كما أشرنا في البداية، هناك قضايا لا يجوز فيها الخلاف مهما كان الأمر، مصادر الاستدلال، قضايا العقيدة، المعلوم في الدين بالضرورة، المجمع عليه وهكذا، لكن قضايا فرعية، اختلف فيها أهل العلم أو نوازل فرعية فهي قابلة ويجب أن تتسع الصدور للخلاف، لكن الخلاف المبني على الدليل ومن أهله، ليس من كل أحد. أيضاً من المعالم، أن العقل له مكانة لكن ليس له حق التطاول على النصوص أو تقديمه على النصوص. أو الحكم على النصوص من حيث النظر العقلي.
أيضاً توضيح بيان قاعدة المصالح والمفاسد، وهي قاعدة تبنى عليها كثير من أحكام النوازل، المقصود بهذه المصالح، المصالح الشرعية والمفاسد أو المفاسد المترتبة عليها شرعاً. أيضاً من المعالم أن نفرِّق بين الحكم الشرعي من حيث هو وبين فعل مكلف من المكلفين، ففعل المكلف ليس هو الحكم الشرعي، فالحكم يكون حراماً ويكون حلالاً، لكن لهذا المكلف المعين قد يتغير الحكم أو يكون في مجال معين يتغير الحكم، من يضبط هذا؟ هو المعلم الأخير أن المرجعية لأهل العلم المعتبرين الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم والنظر والبحث ومعرفة هذه النوازل، ولذلك يجب على الجميع أن يعلي مكانة هذه المرجعية العلمية وأن يعلي احترام أهل العلم وبيان قدرهم، لا أن يأتي كاتب مجهول بتخصص قد يكون مجهولاً ويقوِل: "والله أنا أخالف سماحة المفتي أو أخالف العلاّمة فلان ولي رأيي وله رأيه". لا يا أخي لك رأيك عليك لكن ليس هذا الرأي هو أن يزاد الله سبحانه وتعالى الذي يقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا العالِم ولذلك جاء التحذير الشديد أيما شدة بأن نقول عن الله بغير علم أو أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن القول بالهوى أو بمجرد العقل وحده هو قول على الله وقول على رسوله، فيدخل في الوعيد الشديد "من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". في رواية أخرى "من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار". وحذر الله سبحانه من القول على الله بغير علم بالوعيد الشديد.
هذه جملة من المعالم، يستطيع إلى حد ما أن يضبط طالب العلم المسار المنهجي في هذه المتغيرات، وهذه المعالم هي معالم اجتهادية، هي معالم لتوضيح المسار الصحيح في أن نتعامل مع المتغيرات وليس أن نأخذ منهج الرفض ولا منهج ما يسميه البعض بمنهج التمييع أو منهج الوقت الواقع أو ما يسميه أهله منهج التيسير وهو ليس من التيسير وإنما هو من تمييع الدين، وقد يكون أيضاً مخالفاً لما سبق ذكره.
|



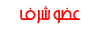

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس